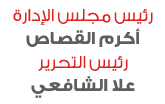صدر عن المركز القومى للترجمة فى مصر، كتاب أعده ثورة فى فهم النصوص الأدبية، وهو "المتحدثون.. الأدب وانفجار الحديث" وهو من تأليف آيرين كاكانديز وترجمة الدكتور خيرى دومة، جاء الكتاب فى خمسة فصول: فى الفصل الأول حددت المؤلفة مفهومها للقصص الحوارى، من خلال شرح الفكرة العامة عن الحديث بصفته تفاعلاً، ومن خلال تطوير أوسع لأفكار محددة مثل أفكار "العرض"، و"والرد"، و"الحديث" التى قدَّمتُها بإيجاز.
واستعرضت المفاهيم الحالية الخاصة بالثانوية الشفاهية، وأشارت إلى الكيفية التى يمكن أن تساعدنا لفهم هُجنة التواصل فى عصرنا. كما نظرت فى الحديث الإذاعى والحديث التليفزيونى للكشف عن التفاعل عبر وسيط، وهى خصيصة بنيوية تشترك فيها هذه الأنواع مع القصص الحوارى.
كل فصل من الفصول الأربعة فى الكتاب، يناقش واحدة من صيغ القصص الحوارى الأربعة، فكل فصل منها يسعى جاهداً للكشف عن طبيعة "النزوع إلى التبادل" orientation to exchange فى تلك الصيغة، عبر مناقشة للظروف التاريخية والثقافية التى تستجيب لها، ومن خلال القراءة الفاحصة لنصوص أدبية متعددة. فى الفصل الثاني، وعنوانه "الحكي: الحديث بصفته وسيلة للبقاء"، تشير المؤلفة إلى أن بعض روايات أواخر القرن العشرين، تتوجه إلى قرائها كما لو كانوا ليسوا مجرد مشاهدين، بل أيضاً وكأن هؤلاء القراء/ المستمعين ملتزمون بالحفاظ على علاقات دائمة بينهم وبين الرواة.
وهى تستخدم مصطلح "الحكي" لتشير إلى ارتباط هذه النصوص بعملية التبادل الشفاهى فى القصص، بما فيها من حميمية وحضور يحاول هؤلاء الرواة إعادة إنتاجهما بطرقهم الخاصة. وتشك المؤلفة فى أن كل ثقافة فى القرن العشرين، كانت ترصد تلك العلاقة المتبدلة بين الشفاهية والنصية، فقد انتقت أمثلتها من ثقافتين اثنتين على وجه الخصوص، كانتا توظفان الحديث لاجتياز المعرفة الثقافية والتاريخية التى تحافظ على الجماعة: تعنى الثقافة اليونانية الحديثة، وثقافة أمريكا اللاتينية. وهذا الانشغال بالتواصل الشفاهى واضح فى نصوص أواخر القرن العشرين- مثل "إكليل الزفاف الثالث" لكوستاس تاشتسيسس، Kostas Tachtsis’s The Third Wedding و"ماما داي" لجلوريا نايلور Gloria Naylor’s Mama Day- حيث العلاقة التى يقيمها كلُّ نص مع القارئ، الذى هو مستمعٌ يتحول بدوره إلى قائم بالحكي. وأبرزت هذه العلاقات بالرجوع إلى نصوص القرن التاسع عشر، مثل "لوكيس لاراس" لديميتريس فيكلاس Dimitris Vikelas’s، و"عبدتُنا" لهاريت ويلسون Harriet Wilson’s Our Nig، حيث كشفت الضجة السردية للاستجابة، عن إيمان بأن خلق علاقة بين النص والقارئ، كان بالفعل وحرفيا، مسألة حياة أو موت. وهى ترى هنا إن علاقتنا مع الحكى بصفته شكلاً أولياً للتفاعل الإنساني، هذا الطلب الملحّ – بالمعنى الأساسي، وبمعنى المحافظة على الحياة- الموجه إلى القارئ بأن "يستمع"، أوحى لى بضرورة النظر فى صيغة الحكى قبل غيرها من الصيغ.
فى الفصل الثالث وعنوانه: "الشهادة: الحديث بصفته معاينة"، تذهب المؤلفة إلى أن الروايات من مجتمعات مختلفة على مدار القرن العشرين، حاولت الاستجابة لما أصابها من صدمة – بسبب الحرب، والأنظمة المستبدة، والعنف المتبادل- عن طريق معاينة أفعال العنف المتفشية هذه. وتقتضى طبيعة الصدمة نفسها تعديلاُ لمقولات الحكى والسماع. بحيث تفيد أن بناء قصة ما حول الصدمة، هى مهمةٌ يتعاون فيها الشاهدُ/ الضحية، ومن يمكنه إذاعة الشهادة. وبينما ينادى القراء فى صيغة الحكى عبر توجيه مباشر بأن يستمعوا (أو يستقبلوا القصة) بما يلائمها من موقف فإن الحديث فى صيغة الشهادة يصعب فك شفرته؛ إذ يجب أولاً أن يدرك القراء النص وكأنه دعوةٌ للشهادة. ثم يجب عليهم بعد ذلك أن يشرحوا الدليل، فى نوع من الاشتراك فى الشهادة يبدع قصة الصدمة للمرة الأولى. ويمكن للشهادة على وقوع الصدمة أن تأخذ شكل أداء نصى قائم على المحاكاة، محاكاة أعراض الصدمة (التكرار مثلاً، والحذف، غياب وجهات النظر الداخلية فى السرد)، أو محاكاة لعملية "الحكي" نفسها (نصوص غير مكتملة مثلاً، أو غير منشورة، أو نصوص أسيء فهمُها، ثم تم تفسير عدم نجاحها فيما بعد، بأنها كانت رؤية عيان أو شهادة على الصدمة). قدمت المؤلفة هنا تحديدا منظومةً من "دوائر المعاينة" التى تفسر الشهادة، وفى مستويات مختلفة من النص: مستوى القصة، ومستوى الخطاب، ومستوى الإنتاج ومستوى التلقي. شرحت هذه الدوائر بإيجاز، مع مساحة واسعة من النصوص المعروفة فى القرن العشرين ("السيدة دالاوي" لفرجينيا وولف، "السقوط لأبير كامي، و"حكاية خادمة" لمارجريت أتوود)، ثم أقدم بعد ذلك معالجة تفصيلية لرواية غير معروفة جيداً، هى رواية "أم يهودية" لجرتروود كولمار، أوضح من خلالها كيف تتداخل دوائر مختلفة، ينتج عنها حديثٌ بين النص والقارئ المعاصر.
أما الفصل الرابع، وهو بعنوان "الالتفات: الحديث بصفته أداءً"، فيستعير من الصورة البلاغية الخاصة بالالتفات عن الجمهور المعتاد، لمخاطبة شخص أو شيء غير قادر على الرد؛ نظراً لأنه غائب، أو ميت، أو جماد، أو لمجرد أن هذا تقليدٌ فني. ورغم أن الالتفات نوقش قبل ذلك باستفاضة فى سياق الخطابة والشعر الغنائي، فإن أحداً لم يلاحظ حسب رأى المؤلف أنه يُستخدم بانتظام فى بعض القصص الحديث، حيث يحكى الراوى قصة بضمير المتكلم (الظاهر أو المستنير) من خلال التوجه إلى أنت لا يردّ. الالتفات استعارة مناسبة تماماً لوصف نمط من أنماط القصص الحواري؛ ذلك أن محتوى الرسالة المنقولة هنا، أقل أهمية من العلاقات الناشئة عن الموقف التلفظى المعقد. إن أبنية المخاطية تتحرك، لا لتشجع ردًّا لفظيًّا يقوم به مخاطبون معينون (وهم إلى جانب ذلك، قد لا تكون لديهم القدرة على الكلام)، بل لتشجع الاستجابة الوجدانية داخل القراء الفعليين. وبينما يمثل إدراك النص فى صيغة الشهادة وكأنه "عرض"، تحدياً تأويلياً بالنسبة للقراء، فإن القراء فى صيغة الالتفات ربما يواجهون مهمة أصعب، مهمة إدراك المخاطبة على أنها ذات طابع مزدوج، فهى لهم وليست لهم فى الوقت نفسه.
يمكنهم أن يختاروا الوقوف عند دور المخاطب، بينما يدركون أنهم يؤدون سيناريو مكتوباً لشخص آخر. وأنا أصف الاستجابات الفعلية والمفترضة للقراء إزاء الأنت الالتفاتية فى رواية "هذا ليس من أجلك أنت" لجين رول، و"التحول" لميشيل بوتور، ورواية جونتر جراس القصيرة "قط وفأر"، وقصة خوليو كورتاثار "جرافيتي"، و"قصة حياة" لجون بارث. ثم أختم بالرجوع إلى النص الذى دفعنى لبحث القصص الحوارى: رواية إيتالو كالفينو "إذا فى ليلة شتاء مسافر". وقد كشفت قراءاتى كيف أن الالتفات- الذى هو مخاطبةُ، وليس مخاطبة بالضبط- تعطينا نوعاً آخر من الرسالة، رسالة حول العوائق المتنوعة التى تقف فى طريق الحميمية فى مجتمعات ما بعد الحداثة، وما السبيل إلى إزالتها.
فى الفصل الخامس، وعنوانه "التفاعلية: الحديث بصفته تعاوناً"، رسمت المؤلفة ما يبدو أن نهاية لعبة القصص الحواري. إن إبتكارات أواخر القرن العشرين فى تكنولوجيات الاتصال أفرزت حقبة من الحكى التفاعلي؛ إذ تؤدى التكنولوجيا إلى تفعيل النزوع نحو التبادلية- وهذا ما لاحظته المؤلفة فى القصص النثرى خلال القرن العشرين – كما أنها أفضت إلى نشاط أعظم من جانب القراء. وإذا فكرنا فى دور القارئ ضمن الصيغة الالتفاتية، باعتبار أنه عنصر مكتوب أو مؤدَّى، فإن كتابة النص نفسها فى الصيغة التفاعلية تتطلب نشاطاً من الجانبين المشاركين فى الحديث، اللذين كان يطلق عليهما تقليدياً اسم "الكاتب" و"القارئ". وأنا أبدا هذا الفصل بتحليل موجز لرواية خوليو كورتاثار الرائدة "لعبة الحجلة"، حيث يُدعى القراء إلى إبداع نصهم الخاص، عن طريق تجميع الفصول فى أحد نظامين.
وبطبيعة الحال، فأن تدعو إلى القراءة بنظام ما، وليس بالنظام التقليدى الذى يمضى من البداية إلى النهاية، فإن هذا يعنى فتح الباب للقراءة فى أى نظام للتتابع، مهما كان ذلك النظام؛ وعلى هذا النحو يمكن أن تعد رواية "لعبة الحجلة" نصاً رائداً فى القصص القابلة للتوالد، القصص التى لا "تُحكى" إلا حين يختار القارئ، وحين ينظم، بل ربما حين يكتب. وأنتهى هنا بالنظر فى نصوص الكومبيوتر الفائقة، والفيديو القائم على التفاعل، وهى الصيغ التى بدأت تتلاشى من خلالها مفاهيم خاصة جداً- كالكتاب، والكاتب، والقارئ- تماماً كما حدث بالنسبة لمفهوم المؤلفة عن القصص الحوارى.