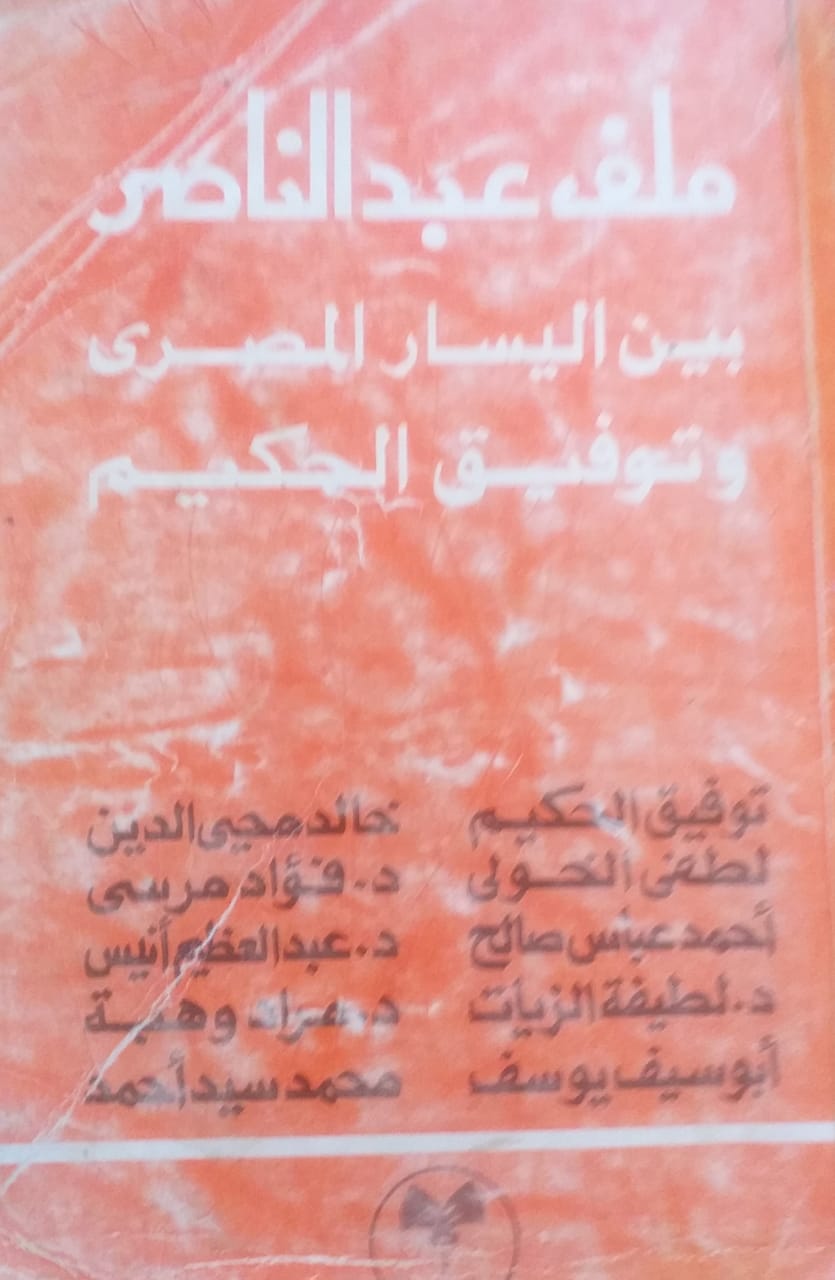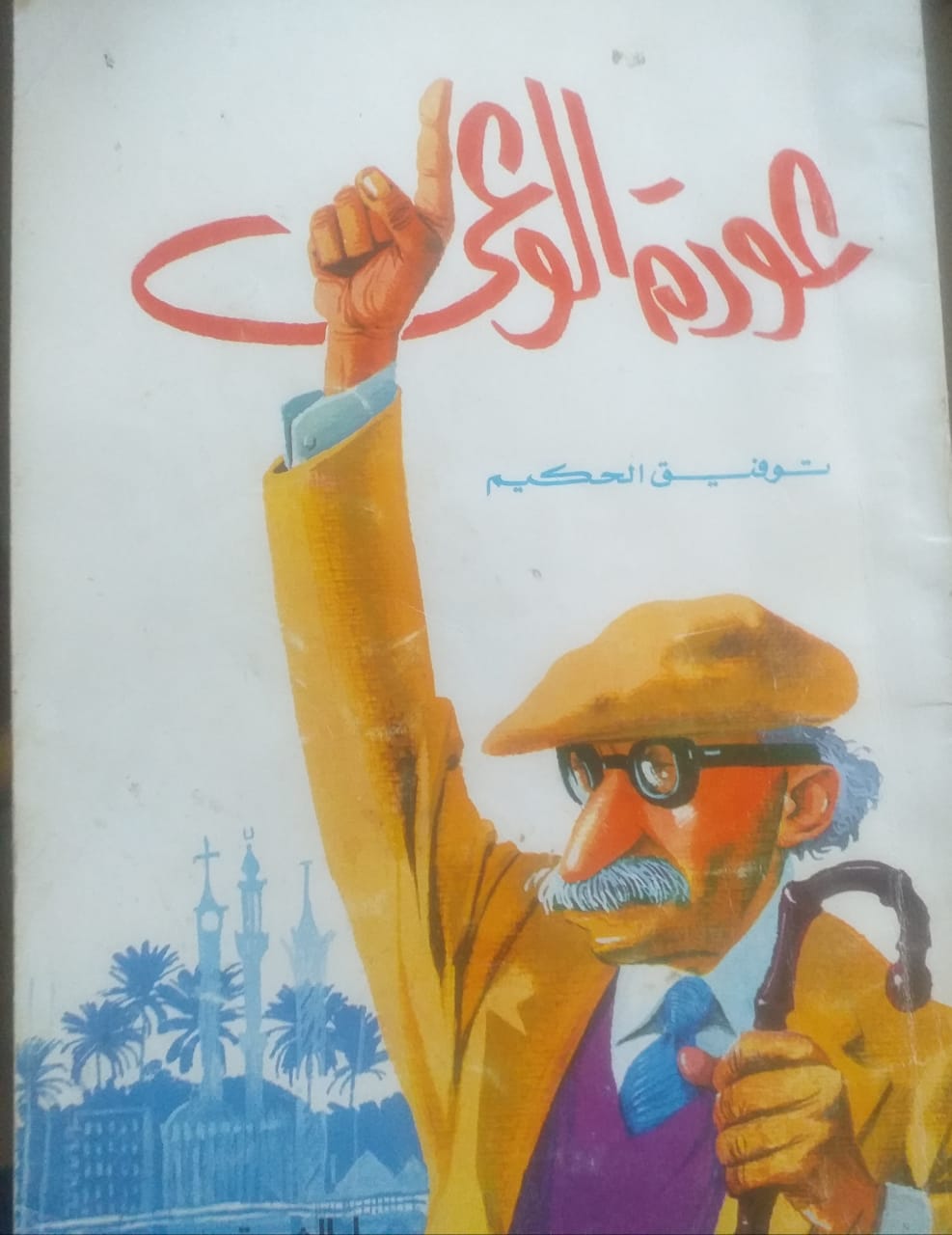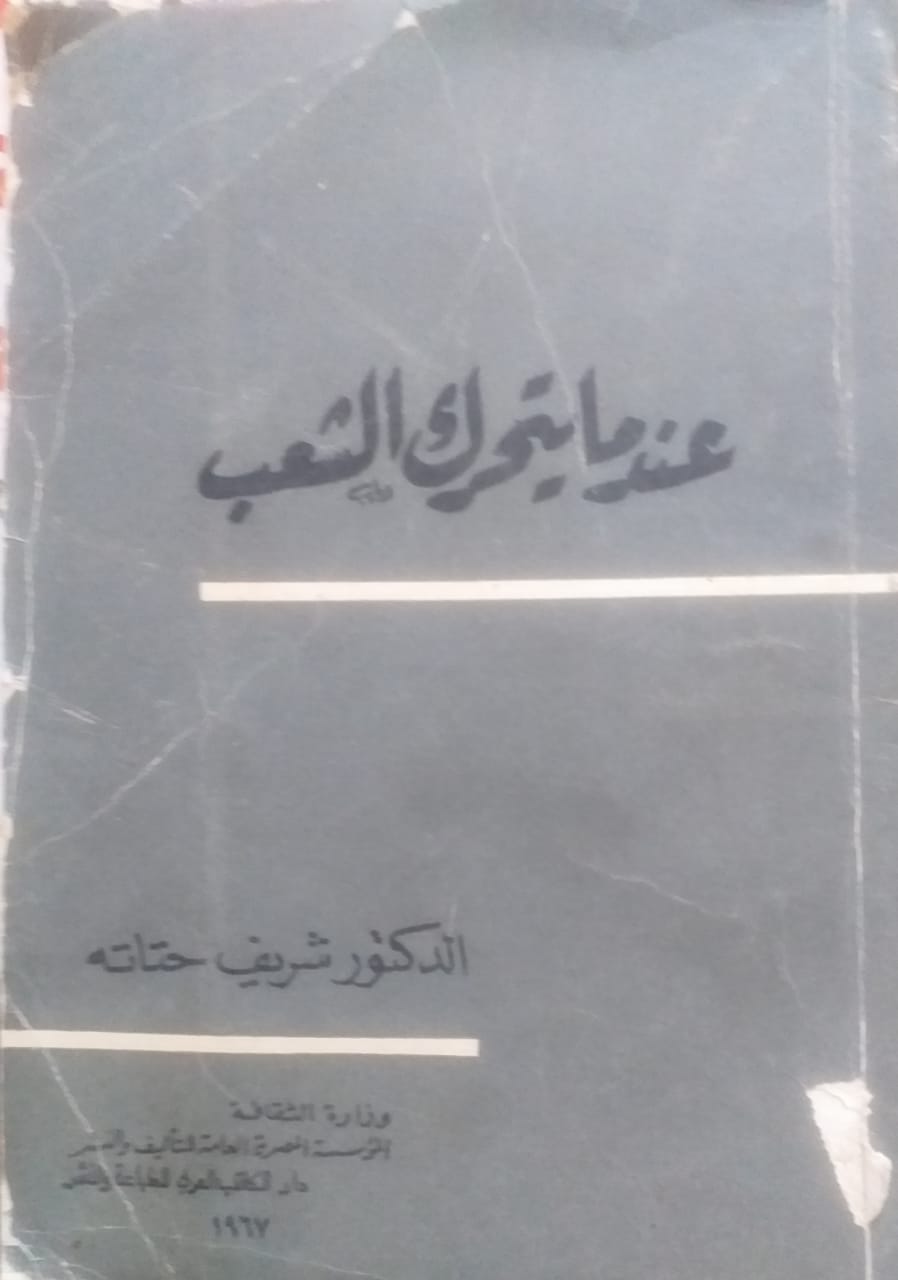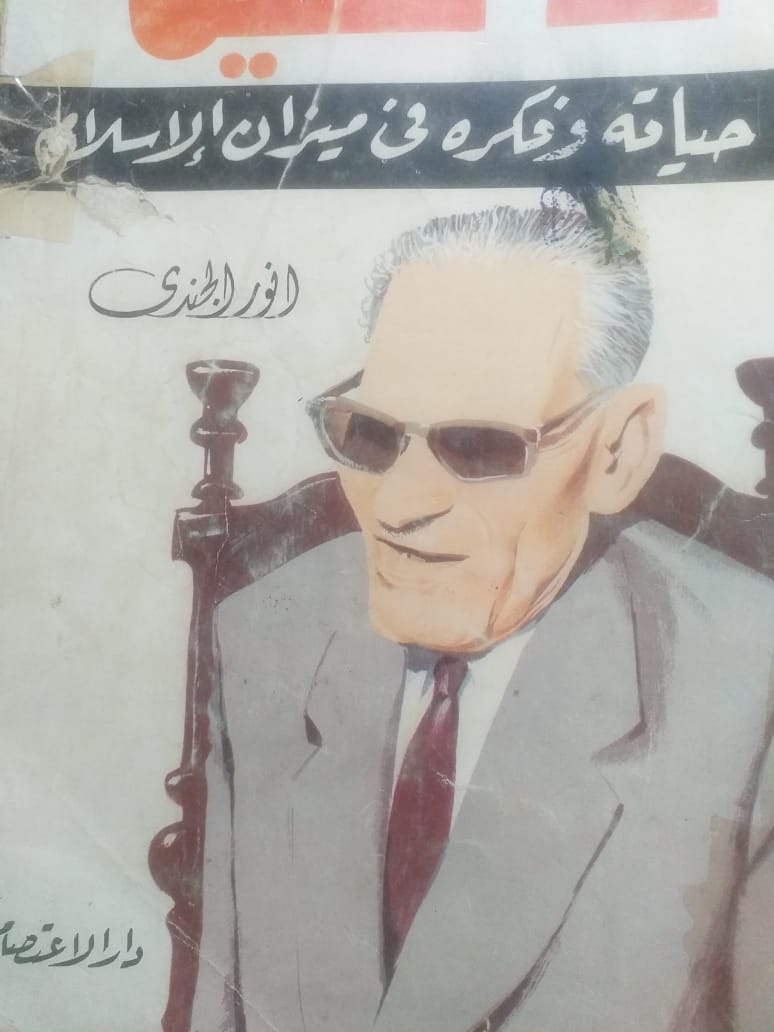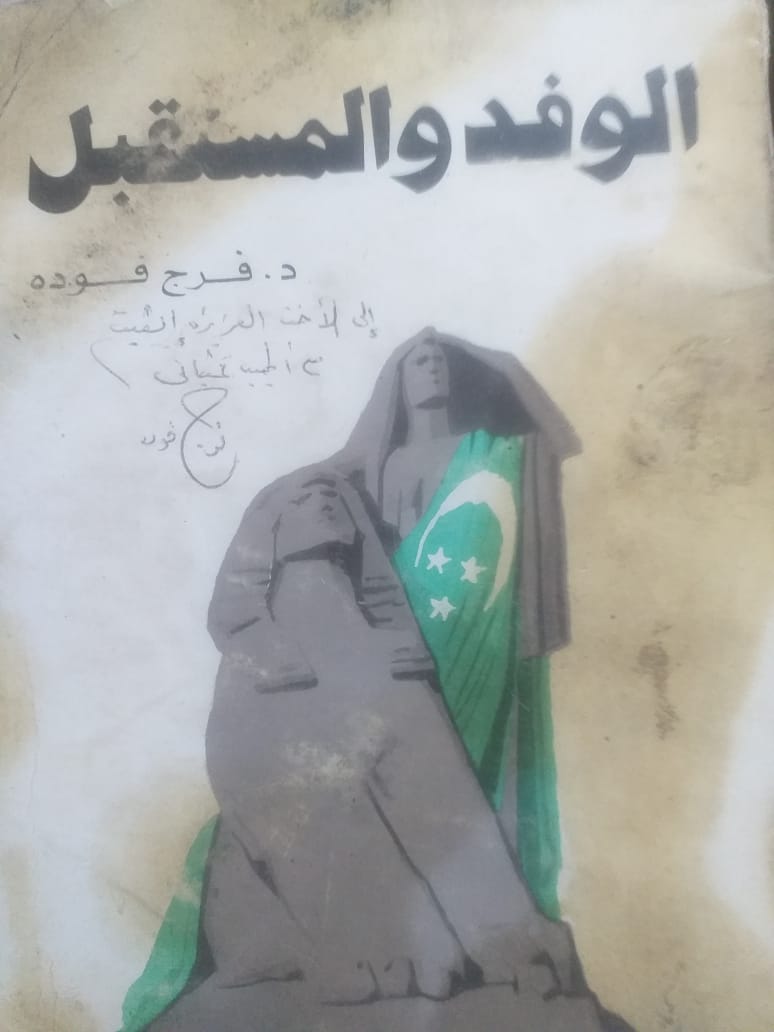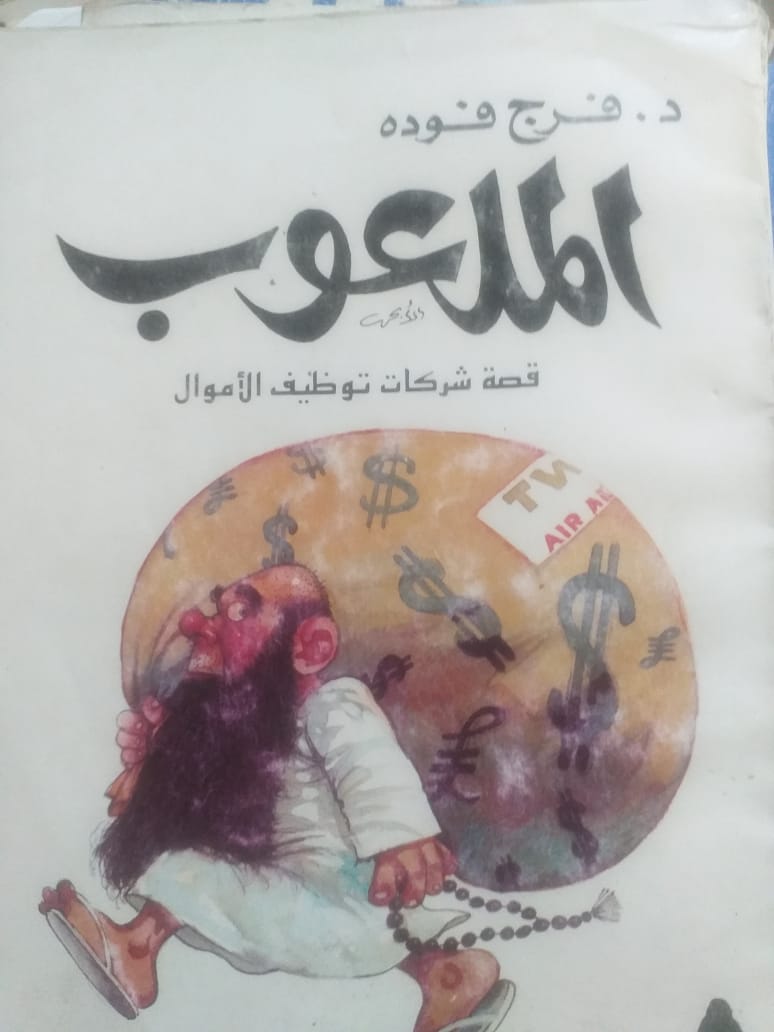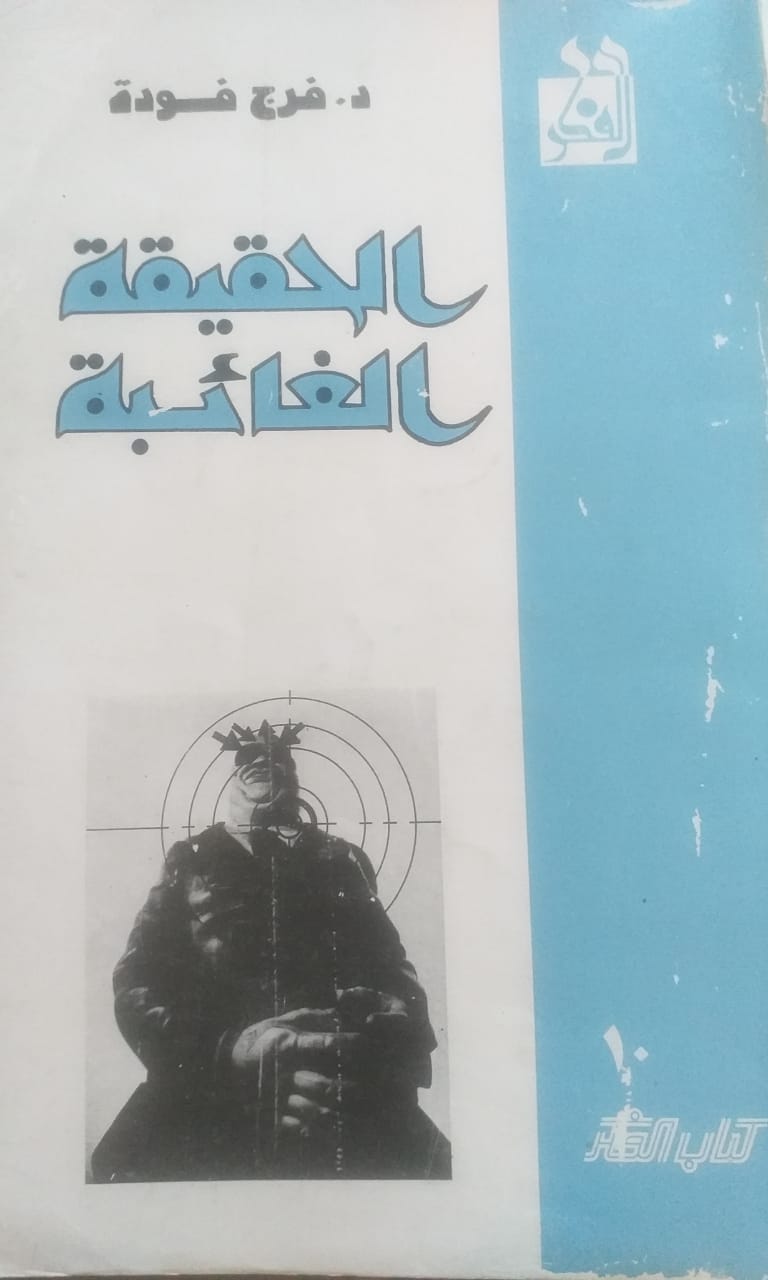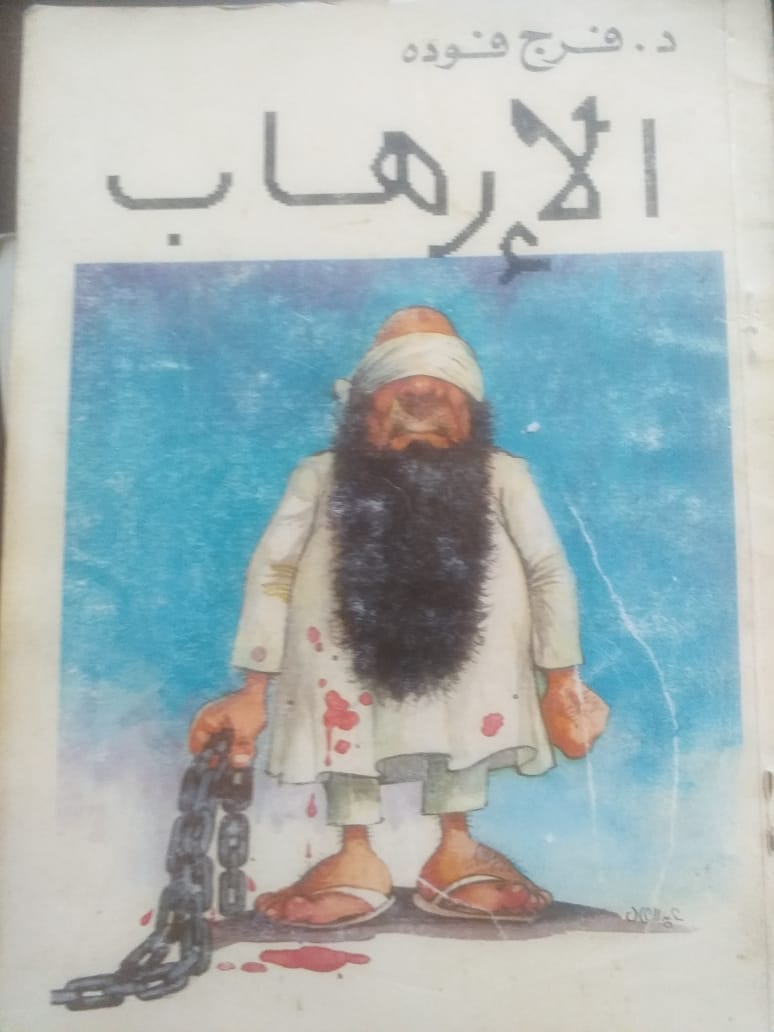ننشر مقالة أدبية للشاعر والناقد شعبان يوسف عن المفكر المصرى الراحل فرج فودة (1945- 1992) وعن علاقته الوضع المصرى منذ الستينيات وحتى رحيله في سنة 1992، كما ينشر قصيدته في رثاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
الانقلابات الكاشفة للمواقف:
عاصر المفكر الراحل الدكتور فرج فودة سلسلة تقلبات حادة على المستويات السياسية والاجتماعية والفكرية، وكانت تلك التقلبات فاصلة بشكل أكثر من درامى، نستطيع أن نقول عنها بكل سهولة ويسر، أنها كانت أقرب بشكل كبير إلى "انقلابات" فعلية، هذه الانقلابات استطاعت أن تكشف كثيرا من أفكار ورؤى كانت كامنة أو مضمرة ومستترة لدى كتّاب ومثقفين ومفكرين ومبدعين كثيرين لأسباب متباينة بدرجات كبيرة، هذه الأفكار سكت عنها أصحابها دهرا، وعندما نطقوا، نطقوا كفرا، وفى أول انقلاب أعلنوا عنها بوضوح دون أى لبس، وخاضوا من أجلها معارك ضارية، وأصدروا فيها كتّبا وبيانات وتحليلات مسهبة، واستعانوا فى تلك التحليلات بنظريات سياسية ذات شأن فكرى واضح، وربما كذلك أكلوا كثيرا من خيرها وشربوا.
ونستطيع أن نرصد واحدا من تلك الانقلابات الحادة والعاصفة والكاشفة بشكل حاسم، أقصد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر- القائد الأول لثورة 23 يوليو 1952 قبل أن ينسب آخرون لأنفسهم أدوارا كانت مجهولة لهم، والذى كشف - أى الرحيل - عن مواقف مضمرة، وكان مسكوتا عنها بشكل قاطع، وربما يكون الكاتب المسرحى الكبير توفيق الحكيم مثالا واضحا للاستجابة لإغراءات البوح ولكل تداعيات ذلك الانقلاب، والذى ظل صامتا أو كاتما شهادته، حتى رحل الزعيم جمال عبد الناصر فى 28 سبتمبر 1970، وبعد ذلك التاريخ بدأت علامات الهجوم عليه وعلى عصره ومنجزاته تظهر رويدا رويدا، وبشكل خافت، حتى حدث بشكل مباغت انقلاب، وهناك من قالوا ثورة 15 مايو 1971، فانفجرت كل البالونات التى كانت صامتة أو مادحة، وراحت تتصاعد الأصوات من جهات مختلفة، أصوات كانت مكبوتة مثل أصوات الأعداء التاريخيين "جماعة الإخوان المسلمين" الذين شمتوا فى كل الكوارث القومية التى لا تخص الزعيم فقط، بل تخص البلاد كلها، وهناك أصوات لمن كانوا خصوما، مجرد خصوم، ثم انخرطوا فى المشاركة للتجربة الناصرية، ولذلك كانت أصواتهم أكثر انحيازا لجمال عبد الناصر بشكل واضح، أقصد الشيوعيين الذين تعرضوا لأسوأ تجربة اعتقال شهدتها الأجيال الشيوعية فى مصر، وذلك فى عام 1959 حتى عام 1964، وفى تلك السنوات الخمس، جرت مياه كثيرة بين السلطة والمعتقلين، مياه امتزجت بالترغيب والترهيب، وأخيرا حدث ما يشبه الاتفاق على حلّ الأحزاب الشيوعية، وعفا الله عن ما سلف، وانخراط أعضائها بأشكال فردية فى تنظيم الاتحاد الاشتراكى - الحزب السياسى الوحيد الذى كان قائما فى البلاد، ومن ثم فقد الشيوعيون سلاحهم الأول، وهو الحزب الذى يستمدون منه قوتهم واستقلالهم ومبررات اختلافهم عن السلطة، وكانوا يطلقون من خلاله كافة احتجاجاتهم وبرامجهم الخاصة، وأصبحوا مجرد أفراد فى صفوف النظام تحت لافتة وحدة قوى الشعب العامل، وبالتالى تحولوا إلى مناصرين ومؤيدين- وأنا لا أدين أحدا، ولكننى أرصد فقط -، وهناك من هتف مادحا السلطة بصدق وقوة وحماس، وذلك تحت لافتات كبيرة أخرى، بعض هذه اللافتات كانت تنشد التعايش السلمى مع النظام، والابتعاد عن شيطنة الحياة السياسية، ومن الممكن أن تعبّر المعارضة الوطنية عن أفكارها بشكل هادئ من خلال المنابر الرسمية دون أن ينالها الأذى المعتاد سابقا، وأستطيع أن أفهم ذلك فى ظل صراعات كانت حادة وتاريخية مع الأنياب الاستعمارية التى كانت مستعدة لتمزيق البلاد ونهبها واحتلالها بطرق مختلفة، كذلك الصراع مع قوى رجعية ومتطرفة داخل البلاد، أقصد جماعة الأخوان المسلمين على وجه الخصوص، هذه الجماعة التى تستمد بعض قوتها بالاتصال مع الخارج والاستقواء به فى كل الأوقات.
لذلك كتب كثير من الشيوعيين بعض العبارات التى تعنى بأنهم لا يريدون المشاركة فى حملة تحطيم التجربة الناصرية عبر ثمانية عشر عاما، وأقرّوا بأنها تجربة تحمل الصواب، كما أنها تحمل الخطأ، كما أنها كانت تحمل أحلاما اجتماعية عظيمة منذ بداية عهد الثورة، وحدث فيها نهوض لكثير من المشروعات التى كانت مؤجلة أو معطلة أو مستبعدة بشكل حاسم، كما أن بعضا من العدالة الاجتماعية والصناعية والسكانية حدثت على مستوى الطبقات الفقيرة، خاصة فى قطاع الفلاحين، منذ قانون الإصلاح الزراعى الذى تم تنفيذه فى بدايات سنوات الثورة، والمساكن الشعبية فى مناطق فقيرة كثيرة، والذى لا جدال فيه أن جمال عبدالناصر _شخصيا_ كان منحازا إلى فقراء هذا المجتمع بشكل قاطع وبدون مساومة مع الرأسمالية، لذا لا يريد هؤلاء الشيوعيون الذين كتبوا مذكراتهم أو تجاربهم فى المعتقل، أن يشاركوا فى تشويه السنوات الثمانى عشرة فى ظل قيادة جمال عبد الناصر رغم تجاربهم المريرة فى المعتقلات، وهذا ما عبر عنه طاهر عبد الحكيم فى كتابه "الأقدام العارية"، الطبعة الثانية عام 1978، عندما كتب فى مقدمته: "لقد كان بيننا وبين النظام الناصرى دم شهداء عديدين سقطوا تحت التعذيب، ومرارة خمس سنوات من السجن والاعتقال والتعذيب والحرمان من أقل الحقوق الانسانية، وفوق ذلك بيننا وبين هذا النظام ما أصاب شعبنا وأصاب النضال الوطنى الديمقراطى العربى كله من نكسات طوال تلك السنوات الخمس التى ساد فيها العداء للشيوعية وللديمقراطية، ومع ذلك فإن القوى الديمقراطية فى مصر هى الأقدر على أن تقدم شهاد حق عند تقييم نظام الرئيس عبد الناصر، وهى الأقدر على أن تثمن ما تم إنجازه فى عهد ذلك النظام من نواحى التقدم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهى الأكثر تصميما على الدفاع عن تلك المنجزات مع التمسك بكل انتقاداتها لما فيها من سلبيات، وهى وحدها التى تمزق القناع عن تلك الحملة اليمينية ضد عهد الرئيس جمال عبد الناصر باسم الديمقراطية"، وهكذا فعل الدكتور فتحى عبد الفتاح فى كتابه الممتع "شيوعيون وناصريون"، وكذلك فوزى حبشى فى كتابه "معتقل لكل العصور"، وأيضا ما سرده إلهام سيف النص، فى كتابه "فى معتقل أبو زعبل"، وكتب كثيرون من الشيوعيين تجاربهم، مع إبداء ذلك التحفظ الذى يعنى أنهم راغبون فى كتابة وتسجيل وقائع تجربة الاعتقال، ولا يعنى ذلك انتقاما من نظام جمال عبد الناصر وتجربة ثورة يوليو، وهذا يختلف تماما عن ما كتبه أحمد رائف فى كتابه "البوابة السوداء.. صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين"، والذى تشفّى بشكل واضح فى كوارث قومية، عندما يقول فى مقدمة كتابه، الطبعة الثانية الشرعية! عام 1985، "..وإن النظام الذى يهدد كرامة الانسان، لا يقوى أمام أى هجمة مهما كانت يسيرة، وإذا أردنا أن نصنع بلدا قويا وشعبا عظيما، فلنعط كل واحد حقه فى حياة كريمة، ولنجعله يأمن من طرقة الليل المفزعة، ومن زيارة الفجر التى تبعث الخوف والذعر فى قلوب الجميع، الرجال والنساء والأطفال، وفى هزيمة يونيو 1967 عظة وعبرة، ولن يتحقق أمن فى دولة مهما ظنت نفسها قوية وقادرة إلا بالقدر من الحرية الذى تسمح به لأفراد شعبها، وفى حادث المنصة أكتوبر 1981 عظة وعبرة..".
ومن الواضح أن ذكر كارثتى هزيمة 1967 واغتيال رئيس الجمهورية عام 1981، كانا مصدرين لسعادة الكاتب وتشفيه، وهو لا يختلف عن كثير من الذين يتربصون فى كل عام عندما تحل ذكرى 5 يونيو، ويولون كلاما مكررا لا يخرج عن ما قاله أحمد رائف، وفى هذا المجال يقول محمد عودة فى مقدمة كتابه المشترك مع عبد الله إمام "النكسة من المسئول": "كورس الندابات حرفة مصرية قديمة منذ الفراعنة وحتى الآن ويتفنن أصحابها فى ممارستها حتى يكاد يصدقهم بعض الناس، وقد انتقلت الحرفة إلى المآتم السياسية، وخلال الخمس عشرة سنة الماضية منذ (ثورة التصحيح) ألفنا مشهد الكورس ينتفض كل عام فى 5 يونيو ولبضعة أيام تالية، يندب ويولول ويشق الجيوب ويلطم الخدود، حسرة وحزنا على ما حدث وما لايمكن أن يعوض، ويشتد الصراخ ويتعالى العويل.."، ولا يقف الأمر عند أحمد رائف فقط، بل يتجاوزه إلى كثيرين من قيادات جماعة الإخوان، وأبرزهم ما كتبته زينب الغزالى "أيام من حياتى"، ومن يقرأ هذين الكتابين وغيرهما من كتابات جماعة الإخوان المسلمين، سيدرك على الفور قدر التشفى والتشويه والمبالغات والانتقام الذى كان يحيط بكل كلمة، وهذا يوضح الفرق بين الخصوم السياسيين، والأعداء التاريخيين والمزمنين على طول الخط.
لذلك لم تلتفت جموع اليسار وقياداتهم إلى كتابات المنتقمين والأعداء المزمنين، ولكنهم هرعوا عندما أصدر توفيق الحكيم كتابه "عودة الوعى"، فى يونيو 1974، معلنا عودة الوعى الذى كان مقموعا أو ممنوعا أو غائبا أو مغمى عليه لظروف وملابسات كثيرة، وراح يتحدث الحكيم عن كل ما لم يستطع قوله بشكل مباشر فى السنوات الثمانى عشرة التالية على قيام ثورة يوليو، ولأن توفيق الحكيم، هو ما هو، توفيق الحكيم المفكر والكاتب والفنان الكبير والأديب، والرائد المسرحى، والذى ذكره جمال عبد الناصر بالاسم عندما تحدث عن تأثير رواية "عودة الروح" على وجدانه، واعتبره جمال عبد الناصر أحد الملهمين الكبار له، والذى بارك خطى جمال عبد الناصر وثورته طوال حياة القائد، لم تفّوت قيادات اليسار تلك الفرصة، فسارع الكاتب اليسارى ورئيس تحرير مجلة الطليعة لطفى الخولى بكتابة رسالة إلى توفيق الحكيم فى 16 نوفمبر 1974، طارحا بعض الأسئلة عليه والتعليقات والاستفسارات حول ما كتبه، وعارضا على الحكيم أن تنظّم المجلة حوارا موسعا معه، وينشر هذا الحوار على صفحات مجلة الطليعة، وفى 17 نوفمبر كتب الحكيم رسالة مطولة يرد فيها على لطفى الخولى، ويوافق على إجراء ذلك الحوار قائلا فى نهاية الرسالة: "..وليس عندى من اقتراح فى هذا الصدد غير قبول الدعوة إلى إجراء هذا الحوار بين من تختارهم أنت من صفوة المفكرين الاشتراكيين الأحرار، على أن تنشر محاضر هذا الحوار، لتكون نواة لمنهج واضح للفكر الاشتراكى فى بلادنا"، وبالفعل سارع لطفى الخولى باختيار مجموعة من قيادات اليسار للمشاركة فى ذلك الحوار التاريخى، وهم: أحمد عباس صالح، خالد محيى الدين، لطيفة الزيات، أبو سيف يوسف، فؤاد مرسى، مراد وهبة، محمد سيد أحمد، بالإضافة طبعا لتوفيق الحكيم ولطفى الخولى نفسه الذى ترأس جلسات الحوار، والذى كتب ورقة العمل، واستمر الحوار على مدى تسعة أشهر، وكانت المجلة تنشر الحوارات طوال تلك الشهور، وفيها استفاض كل من المحاورين فى وجهة نظره فى جمال عبد الناصر وثورته ونظامه وقراراته وإنجازاته وانتكاساته، وبعد ذلك تم جمع تلك الحوارات وإصدارها فى كتاب كان عنوانه "ملف عبد الناصر بين اليسار وتوفيق الحكيم" فى نهايات عام 1975 عن دار القضايا.
هناك طبعا من حاولوا استثمار ذلك الانقلاب بكل ثماره الرابحة، ونافقوا العهد الجديد كذلك ليحصلوا على مكاسب فى كل المجالات الثقافية والإعلامية والحكومية، وسوف نلاحظ أن اليمين واليسار والوسط! شاركوا فى هذا العرض الشامل والكامل والمربح والاستثنائى تاريخيا، والذى بيعت فيه أثمن المعانى والألقاب بأرخص الأسعار، البضاعة التى كانت معروضة الكذب والمغالطات والتخوين والتكفير والتسخيف، وكل من كان يخرج عن الخط المرسوم، كان نصيبه التقريع والسحل الصحفى والتعريض الشامل والكامل، وليس بعيدا استخدام الأخبار الشخصية للتشهير بالخصوم، كان أى أحد يتحفظ على ما يحدث، تصيبه إحدى هذه السلع المعروضة للبيع، وسمعنا الذين كانوا غارقين فى حب ناصر سابقا، يلعنونه فى أول منعطف، ولو قرأنا معلقات شاعر مثل صالح جودت فى مديح الزعيم ناصر فى حياته ورثائه بعد رحيله مباشرة، لاندهشنا من مقالاته التى هاجم فيها عبدالناصر وعصره بطريقة فجة.

الجيل الجديد وفرج فودة:
ولكن فى ذلك السياق لا نستطيع أن ننسى ذلك الجيل الذى عاش عنفوان صباه وشبابه فى ظل انتصارات وشعارات وأحداث مجيدة لثورة يوليو وقائدها، وذلك منذ إسقاط الملكية عام 1952 وإزاحة الملك من الحكم، ثم قانون الإصلاح الزراعى عام 1953، والجلاء عام 1954، وعملية التسليح عام 1955، ثم تأميم قناة السويس عام 1956، حتى قوانين يوليو فى مطلع الستينات والتى وصفت بالاشتراكية وهكذا، حتى أن وصلنا إلى عام 1967 الذى حدثت فيه الكارثة القومية الكبرى، الهزيمة، أو النكسة كما يحب أن يقول الناصريون، مما دفع جمال عبد الناصر إلى أن يعلن انسحابه من القيادة، ويقترح اسم زكريا محيى الدين أن يتولى القيادة، وكان شائعا أن زكريا محيى الدين قريب من القيادة الأمريكية وسياستها فى المنطقة، والتى أثبتت أنها هى المتنفذة فى سياسة الشرق الأوسط، ولا بد أن يتولى من يستطيع التفاهم معها، ولكن الشعب المصرى خرج فى مظاهرات تاريخية جارفة للانتصار لجمال عبد الناصر، وإثناء عزمه عن التنحى أو التخلى أو الانسحاب، ورفعت الجماهير شعارات كثيرة جدا منها "ارفض ارفض يا زكريا، عبد الناصر ميه الميه"، و"عبد الناصر يا حبيب، بكره هندخل تل أبيب"، كما كتبت الجماهير على الجدران "حنحارب ..كل الناس حتحارب، ولا يهمك يا ريس .. م الأمريكان يا ريس..، وتفاقمت المظاهراتـ وخرجت الجماهير بشكل جنونى فى أعداد حاشدة، وذهبت إلى منزل الرئيس فى ضاحية منشية البكرى التى يسكن فيها الزعيم هاتفة مرة أخرى أمام بيته: "ناصر .. ناصر/ بالروح بالدم نفديك يا جمال، لا سلام ولا استسلام، يا خالد قول لابوك..100 مليون بيحبوك، ارجع ارجع يا جمال .. شعبك كله رجال أبطال، يابو خالد لا تهتم.. الحرية تمنها دم" وكتب عبد الرحمن الأبنودى أجمل أغانيه، رغم أنه كان معتقلا منذ أكتوبر 1966 حتى مارس 1967، ولم يحتج، ولم يشمت، ولم يمارس أى محاولات للتبكيت، وتكونت فى ذلك الظرف التاريخى فرقة "ولاد الأرض" فى مدينة السويس بقيادة رجل بسيط جدا هو الشاعر والكابتن غزالى، وغنت الفرقة أغنيات مفعمة بالأمل وروح المقاومة على إيقاع الآلة العذبة والمحلية (السمسمية): "فات الكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل، بينا ياللا بينا.. نحرر أراضينا، وعضم ولادنا نسنه نسنه ونعمل منه مدافع.. وندافع، ونجيب النصر هدية لمصر"، وكتب شريف حتاتة الشيوعى الذى حوكم وقضى عشر سنوات كذلك فى المعتقلات، وأصدر كتابا عنوانه "عندما يتحرك الشعب"، بعد المظاهرات مباشرة عام 1967، ويكاد الكتاب يكون مجهولا، قال فيه: "والمشاهد لمظاهرات صباح 10 يونيو يدرك على الفور من فقراء الكادحين من الفلاحين والعمال وصغار العاملين والمثقفين هم الذين هبوا للدفاع عن الثورة وعن مستقبل البلاد، وعن كل ما حققناه بالنضال عبر السنين الماضية، بينما مكثت القيادات الإدارية والسياسية المثقفة فى بيوتها، تناقش الموقف وتزن احتمالاته المختلفة، وهكذا تأكد مرة أخرى صدق النظرة التى تقول أن حماة الثورة هم أصحاب المصلحة الأساسية فيها، وأنه قد آن الأوان لكى يلعبوا دورا بارزا فى تسيير شئونها وتحديد اتجاهاتها".

التجربة الشعرية:
إذن كان هناك جيل جديد يعيش كل هذه الأحداث التى أعقبت ثورة يوليو بحلوها ومرها، وبكل مشاعره ووعيه، تلك الأحداث التى كانت تمثّل انتصارات بشكل ما، وإنجازات بشكل ما، وتم انتكاسها عام 1967، ولكن سرعان ما استكملت الثورة دورها فى الإعداد لحرب الاستنزاف، وكان الجيل الذى ضمّ فى إهابه مؤيدين ومتمردين ومحتجين، قد اتسع لمثقفين ومبدعين من طراز فرج فودة الشاب المتحمس، والذى كان معيدا مازال فى كلية الزراعة جامعة عين شمس، وكان يكتب الشعر والأغانى، وله قصائد منشورة باللغة الفصحى فى مجلة الشعر منذ عام 1964، وكان يكتب باسمه الثلاثى "فرج على فودة" ثم كتب قصائد بالعامية على غرار بيرم التونسى مثل:
(الأوله آه
والثانية آه
والثالثة آه
الأوله شخص وفدى وقال كلام للناس
الثانية أحلى كلام منقول عن النحاس
والثالثة بعض الكلام خايب وماله أساس
الأوله شخص وفدى قال كلام للناس وأذانى
والثانية أحلى كلام منقول عن النحاس وأشجانى
والثالثة بعض الكلام خايب وماله أساس وبرانى
الأوله شخص وفدى قال كلام للناس وأذانى عشان فى الوفد
والثانية أحلى كلام منقول عن النحاس وأشجانى زعيم الوفد
والثالثة بعض الكلام خايب وماله أساس وبرانى وعيب ياوفد)
هذه القصيدة كتبها فرج فودة عام 1991، ومن الواضح طبعا أن ثأرا سياسيا ما كان بينه وبين حزب الوفد، والذى انشق عنه قبل ذلك بعدة سنوات، وكان حزب الوفد قد عقد حلفا شيطانيا مع جماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات، وهذا ما لم يقبله فودة، ولم يساوم عليه، وظل معتنقا لمبادئه حتى استشهاده، وبعد محاولة لإثناء قيادة الحزب عن ذلك، لم يرضخ الحزب لما طرحه فرج فودة من عدم التعاون مع جماعة الإخوان، لكن دون جدوى، فالتمثيل البرلمانى كان مغريا بقوة لقيادات الحزب، وجماعة الإخوان لها أساليبها القوية فى شأن الانتخابات، فما كان من فرج فودة إلا أن يحتج وينسحب ويستقيل وينتقد سياسة الحزب، ويظلّ مستقلا خارج أى حزب سوى الحزب الذى كان يسعى لتأسيسه "حزب المستقل"، بعد أن تفرّغ للبحث فى مجال دراساته وأبحاثه، رغم أنه كان يكتب فى صحف حزبية مثل جريدة مايو لسان حال الحزب الوطنى الديمقراطى، أو فى جريدة الأحرار لحزب الأحرار، ولكنه لم يتأثر بسياسة حزب من الأحزاب، وكان قد أصدر كتابه الأول "الوفد والمستقبل" عام 1983، وفيه كان مفتونا بتاريخ حزب الوفد ومنهجه وبرنامجه وطموحاته ومراميه وإنجازاته، وقد ظنّ أن حزب الوفد الجديد سوف يسير على خطى الوفد القديم، ولكنه لم يفعل، وهذا ما لم يرض عنه فرج فودة، فاستقل واستقال وكرّس كل جهوده للبحث والدرس الفكرى الذى تصدّى فيه لمهمته التاريخية والتى أودت أخيرا بتعقب الظلاميين له، وترصدت حركته وخطاه وأفكاره كل جماعات المتطرفين، ويستشهد برصاصهم الغادر فى 8 يونيو 1992، وكان عمره 47 عاما فقط، وكان ظهوره الفكرى لم يتجاوز عشر سنوات، ولكنه فى تلك السنوات العشر قد زلزل الأرض من تحت أقدام الظلاميين، ولم يجدوا أى سبيل معه سوى القتل، بعد أن هزمت كل وسائلهم الحوارية والفكرية، وضربوا المعنى الحقيقى الكامن فى الآية الكريمة " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن، إن ربك أعلم هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين" عرض الحائط، ورغم أن فرج فودة رحل بجسده، لكن تظل معركته قائمة، وأفكاره سارية، واسمه عاليا أبدا فى مجال التنوير.
قصيدته فى رثاء الزعيم:
إذن كان فرج فودة قبل أن يدخل فى معاركه الفكرية مع الظلاميين، شاعرا، ومحبا وعاشقا لجمال عبد الناصر، ويبدو هذا فى قصيدته التى نشرها فى 5 أكتوبر 1970 بجريدة الجمهورية فور رحيل جمال عبد الناصر بأيام معدودة، ونستشف من خلال القصيدة التأثر الواضح بالحزن، مع اعتبار أن فرج فودة استعار روح القصيدة من الأهازيج التى كانت تؤلفها الجماهير وترددها فى جنازة الزعيم، والقصيدة عنوانها "الحرب ما انتهتش!، وهنا القصيدة كاملة:
(جمالنا لسه حى
فى قلب كل الناس
فى كل لمحة حتى
فى كل ضربة فاس
فى رعشة إيد حبيبه
كتبت على الكراسى
بابا جمال مامتشى
والحرب ما انتهتشى
الحرب ما انتهتشى
+++++
ياحارس البيوت
هى الرجال تموت
علمتنا نختار
نمشى الطريق الصعب
وان الرجال تنهار
ممكن يعيش الشعب
وهناك على الحدود
ولادك الجنود
بيقولوا لاأ ما مامتش
والحرب ما انتهتش
الحرب ما انتهتش
+++++
كبير ياشعب مصر
كبير على الهزيمة
دمع الرجال مش دمع
دمع الرجال عزيمة
ومش أول شهيد
ولا آخر شهيد
لكن ... وده أكيد
جمال جمال مامتشى
والحرب ماانتهتشى
الحرب ماانتهتشى).
الانتماء لحزب الوفد الجديد:
ومن الواضح أن فرج فودة المعيد بزراعة عين شمس، كان متأثرا كما قلنا برحيل جمال عبد الناصر، وبكافة الشعارات والأغانى والأهازيج التى تتردد فى جنازته الضخمة، الجنازة التى أصبحت علامة تاريخية على حب هذا الشعب لقائده مهما كانت الانتقادات، وهذا حدث فى جنازات زعماء كبار مثل مصطفى كامل وسعد زغلول، وكذلك جنازة مصطفى النحاس لولا الظروف والملابسات التى كانت قائمة عند رحيله، وأبرزها الخصومة التاريخية بين ثورة يوليو وحزب الوفد، وبالطبع لا مجال هنا لقراءة القصيدة من الزوايا الفنية، فهذا ليس هدفنا، وكذلك لتواضع قيمتها من هذه الزاوية، ولكننى أرصد التماس الأول بين فرج فودة وجمال عبد الناصر، هذا التماس الذى أعلن فيه _شعرا_ انحيازه لجمال عبد الناصر فى حالة عاطفية عامة وعارمة، وهى حالة الرحيل المفاجئ والمدوّى، وكان فرج فودة مازل فى الخامسة والعشرين من عمره، ولم تكن قد تكونت ملامحه الفكرية الشاملة التى عرفناها فيما بعد، عندما راح يعبّر عن نفسه وأفكاره وبرنامجه وتوجهه نثرا وفكرا.
مرّت أكثر من عشرة أعوام على رحيل الزعيم ناصر، وكانت قد جرت فى نهر فرج فودة مياه كثيرة، منها المياه العذبة، ومنها المياه المشوبة ببعض العكارة، وعلى رأس هذه التجارب انضمامه لحزب الوفد، ذلك الحزب الذى شكّلت أفكاره وجدان فرج فودة، فأعطاه كل جهده، وكان هذا الانتماء الأصيل لحزب الوفد، هو بمثابة انحياز لخصوم جمال عبد الناصر، ليس لدينا ما نستطيع أن نتبيّن من خلاله الخطوط التى رسمها فرج فودة لنفسه فى السنوات التى فصلت بين قصيدته المنشورة بعد رحيل جمال عبد الناصر عام 1970، وبين صدور كتابه الأول "الوفد والمستقبل" عام 1983، والذى باح فيه بالكثير من مشاعره وتجربته، وتعرّض فيه لكثير من أفكاره السياسية، وتوجهه الفكرى، مسترشدا فى ذلك بتجربة حزب ثورة 1919، حزب الوفد الذى تأسس بمبادرات شعبية ووطنية كبرى، منذ أن ذهب الزعيم سعد زغلول للمعتمد البريطانى فى 13 نوفمبر 1918 ومعه رفاقه، للمطالبة بحقوق الاستقلال الوطنى لمصر، ولكن المعتمد البريطانى طلب من سعد زغلول ما يثبت بأنه نائب عن الشعب، من هنا انطلقت شرارة التوكيلات لتفويض سعد ورفاقه لكى ينوبوا عن الشعب ويتحدثوا باسمه، ويطالبوا بحقوقه المهدرة فى الاستقلال الوطنى، وكانت هذه أولى بوادر ثورة 1919، وكذلك النواة التى انبنى عليها حزب الوفد الشعبى، والذى قاد الحركة الشعبية أكثر من ثلاثة عقود ونيف، حتى جاءت ثورة 23 يوليو وألغت نظام الأحزاب جميعا، وأنشأت بديلا عن ذلك "هيئة التحرير"، ثم "الاتحاد القومى" ثم "الاتحاد الاشتراكى" كبدائل سياسية عن الأحزاب التى كانت قبل قيام الثورة، وجدير يالذكر أن 13 نوفمبر كان عيدا وطنيا تحتفل به مصر كلها كل عام، وبالطبع حزب الوفد بشكل أساسى.
فى بداية الكتاب يعرض فرج فودة لمشاهد سياسية حدثت فى عهد الرئيس محمد أنور السادات، أبرزها عندما تم إعلان حزب مصر، ذلك الحزب الذى ترأسه السيد محمود أبو وافية، ويعلن هذا الأخير كامل إخلاصه وولائه لحزب مصر، كما ينوّه عن ثقته فى كل أعضاء الحزب العظيم، وفى مفاجأة مذهلة، وبدون أى مقدمات، أعلن الرئيس السادات بأنه سينشئ حزبا جديدا تحت مسمى جديد، وهو "الحزب الوطنى الديمقراطى"، ولكن أبو وافية كان مصرّا على تمسكه بحزب مصر، معتقدا أن أعضاء الحزب لن يغادروا مواقعهم تحت أى ضغوط سياسية، ولكنهم باعوه بقسوة، وأعلنوا أنهم مع الرئيس أينما كان، وكيف كان، وظلت عضوية الحزب الوطنى الديمقراطى تتسع، وراح صوته يعلو ويكبر وينمو فى كل أنحاء المحافظات برئاسة ممدوح سالم الذى كان وزيرا للداخلية، ثم صار رئيس وزراء، وانكمش حزب مصر وتضاءل حتى انتهى، وانتهى كذلك محمود أبو وافيه على المستوى السياسى إلى الأبد.
وقبل أن نتعرض لكتاب "الوفد والمستقبل"، أود أن أشير لكتاب آخر صدر فى سبتمبر 1977 عن دار الشروق، وهو كتاب "لماذا الحزب الجديد" للباشا فؤاد سراج الدين الوفدى العتيق، والذى كان ضالعا فى حزب الوفد القديم قبل قيام ثورة 23 يوليو، وقدّم له اثنان من خصوم جمال عبد الناصر، الأول هو صاحب الدار شخصيا "محمد المعلم" والذى راح يزهو فى مقدمته بأن دار الشروق تفخر بأنها نشرت كتاب "عودة الوعى" لتوفيق الحكيم عام 1974، وها هى تنشر كتاب "لماذا الحزب الجديد" آملا فى أن يحدث الصدى الذى أحدثه كتاب توفيق الحكيم، ومغازلا ثورة التصحيح التى قامت فى 15 مايو، وحطّمت القيود والأغلال التى كانت مفروضة فى العهد الناصرى، أما الثانى فهو الأستاذ مصطفى البرادعى، نقيب المحامين آنذاك، وهو يرى أن عهد عبد الناصر كان عهد "حروب وهزائم وتضييع للقيم والقضاء على الانسان العربى الحر بما لا داعى لتكرار الحديث عنه وإثارة الأسى والألم"، فضلا عن إضافته ل "حكم مطلق ساعد على انتشار الأمية فى هذا البلد"، فإذا كانت مقدمتا الكتاب على هذا الطريق، فما بالنا بحديث فؤاد سراج الدين نفسه الذى جاءته الفرصة الذهبية والتاريخية لكى يقول ما لم يستطع أن ينطق به قبل ذلك، وأثار الكتاب جدلا كبيرا بالفعل عند صدوره، فلم يكتف الذين ردوا عليه بمقالات سيارة فى الصحف، ولكن صدرت كتب كاملة للرد عليه، واحد من الكتابين للأستاذ محمد عودة، والثانى للأستاذ حسنين كروم، وكان الطرفان، أى فؤاد سراج ورجاله من ناحية، ومحمد عودة وحسنين كروم من ناحية أخرى، قد أشعلوا الساحة السياسية بمعلومات وتحليلات وأفكار وأحداث ورؤى كانت غائبة عن الساحة لزمن طويل، فؤاد سراج الدين وقادة حزب القدامى والجدد، كان المناخ ملائما ومتاحا ومناسبا لكى يقولوا كل ما فى جعبتهم من مظالم ومن مآخذ ومن افتراءات وأكاذيب على سلطة يوليو منذ عام 1952، وكان وضع الناصريين حرجا إلى حد كبير، إذ كانت الريح ليست مواتية لهم على الإطلاق، ولقد تكسّرت النصال على النصال كما يقولون، وهناك عداء معلن وسافر من ناحية كثير من الكتّاب الذين كانوا شركاء الأمس فى التجربة الناصرية، وكذلك عداء مضمر من القادة السياسيين فى السلطة، وبالتالى كانت المعركة ساخنة إلى حد كبير.
ورغم أن قيادات حزب الوفد القدامى والجدد الذين تزعموا حزب الوفد الجديد كانوا حانقين على ثورة يوليو وقائدها بشكل غير طبيعى أو طبيعى بحكم العداء المستحكم بينهما، إلا أن د فرج فودة كان يحاول أن يكون موضوعيا، وكل ما كان يبغيه فى كتابه، هو عرض برنامجه المستلهم من أفكار حزب الوفد القديم، وقد بدت فى هذه الأفكار بدايات الانحياز لدى فودة ضد التطرف بشكل واضح، وفى هذه النقطة 0يقول فودة بشكل موضوعى على عكس القادة الكبار:
"..وباختصار ووضوح ..ثأرنا الحقيقى مع أعداء مصر.. إننا علينا أن نذكر العديد من الأخطاء لثورة يوليو، لكن واجبنا أن نعترف لها بثلاثة إيجابيات مؤكدة:
أولها: أنها أحدثت تغييرا اجتماعيا حقيقيا وعادلا.. حتى مع اعتراضنا على شرعية بعض الوسائل، هكذا كان التغيير هدفا من أهداف الوفد، وهو تغيير لا يمكن تجاهله، ولا تجاهل النتائج المترتبة عليه، وهو تغيير إيجابى بالتأكيد.
ثانيها: أنها حرصت على الفصل بين الدين والسياسة حتى سبتمبر 1970، وحفظت الوحدة الوطنية للأمة حتى ذلك التاريخ.
ثالثها: أنها حرصت لفترة طويلة بعد قيامها على أن تجعل السياسة بعيدا عن الجيش، وبمعنى آخر حرصت على عدم تسييس الجيش، فلم تصبغه بفكر سياسى، وهو ما فعله حزب البعث فى سوريا والعراق، وما ترتب عليه فى هذين البلدين من محنة الديمقراطية لا يجد أبناء الشعب منها خلاصا .."
لا أظن أن وفديا مخلصا لمبادئ حزب الوفد الأصيلة، أو من أعضاء حزب الوفد الجديد، كان يمكن أن يقول هذا الكلام، فالعداء المستحكم بين ثورة يوليو، وورثة حزب الوفد، لا مزاح ولا مساومة فيه، وعندما تأتى سيرة جمال عبد الناصر أو ثورة يوليو، فلامجال للحياد على الإطلاق وكذل لا للموضوعية، ولأن فرج فودة كان يتسم بالدرس الفكرى والنقدى العلمى، كان قادرا على رؤية الأحداث والشخصيات بقدر من الحيادية، فهو شاء أم أبى، ابن ثورة يوليو التى قامت وهو فى السابعة من عمره، ولم يتعرّض لأى أذى اجتماعى أو اقتصادى فى سنوات سلطتها، وكذلك أسرته، فهو أحد أبناء فارسكور الذين استفادوا من التعليم المجانى، وكذلك ابن الطبقة المتوسطة التى استفادت من الإصلاحات الاجتماعية فى التعليم وخلافه، لذلك وكما صرّح بدقة، بأنه ليس له أى ثأر مع ثورة يوليو، رغم أنه بعد نكسة 1967_ما لم يعرفه كثيرون_، خرج مع الطلاب فى مظاهرات عارمة، ودخل معتقل القلعة كما دخل كثيرون مثله، ورغم كل ذلك فمن الضرورى أن نتذكر القصيدة التى كتبها فى رثاء ناصر، فهو خليط _أى فرج فودة_ من الحب والغضب والتمرد والاحتجاج والوله والانتماء للأرض المصرية، وسوف نلاحظ أن قضيته فى القصيدة هى "الحرب" التى بدأها جمال عبد الناصر، ولم تكن قد انتهت، وهى حرب الاستنزاف التى بدأت منذ أن وقعت الهزيمة بقليل، أى أن الحزن عند فرج فودة فى القصيدة، ارتبط بقضية قومية عليا.
ثورة يوليو بين فرج فودة وفؤاد زكريا:
كان هذا موقف فرج فودة من جمال عبد الناصر وثورة يوليو عام 1983، ونستطيع أن نرصد ثمة تغيرات قد حدثت فى ذلك الموقف، فنبرة الحديث تنطوى على ذلك الابتعاد الذى صنعه انضمامه لحزب الوفد، وعندما استقال من حزب الوفد، واستقل، وأصبحت وجهة نظره تخصّه وحده بشكل كبير، زاد موقفه ابتعادا، ولكنه ليس الابتعاد العدوانى، بل ذلك الابتعاد الذى يتحفظ على الشخص، كما أنه بدأ يربط الظواهر السياسية بالموقف الفكرى، كما أنه فى معركته مع التيارات المتطرفة، لم يبالغ فى عداوته، ولكنه كان يكتب بحكمة ما، حكمة المفكر والباحث، وليست خصومته مع ناصر أو ثورة يوليو، ولكن خصومته مع المؤدلجين المتطرفين، ولأنه كان مؤمنا بأن السلطات دائما قادرة على كبح جماح التطرف، أو إطلاق يده حرة تنهش فى لحم المجتمع، فقد عرّج على العلاقة التى كانت بين ثورة يوليو وجماعة الإخوان المسلمين، وهذه العلاقة تطرّق إليها باحثون كثيرون، وكانت محل جدل دائم فى كتابات كثيرة، للدرجة التى زعم فيها حسن العشماوى القائد الإخوانى فى مذكراته، وصرّح بأن جمال عبد الناصر كان عضوا بجماعة الإخوان، وله اسم حركى هو زغلول عبد القادر، فى هذا السياق يقول فرج فودة فى كتابه "قبل السقوط"، والذى صدرت طبعته الأولى 1985: (فى بداية الثورة، كان لكثير من الضباط الأحرار علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وهى كما أراد لها مؤسسها جماعة، وليست حزبا، وحجة مؤسسها فى ذلك أنهم لا يطمحون إلى حكم أو عرض دنيوى زائل، وإنما يستهدفون هداية المجتمع إلى طريق الحق، ولا يعنيهم إلا بناء الانسان المسلم، والدعوة إلى تطبيق شرع الله، ويجمع كثير من على أن بعض الإخوان المسلمين كانوا يعلمون بموعد قيام الثورة، ويرى البعض أنهم ساندوها بمجرد قيامها بالإعلان عن تأييدهم، وأن رجال الثورة أرادوا رد الجميل للجماعة فطلبوا منهم ترشيح وزيرين للاشتراك فى الوزارة، وحدث اختلاف حول اسمى الوزيرين، وأصر الإخوان على مرشحيهم، بينما قبل الأستاذ الباقورى ترشيح مجلس قيادة الثورة وترك الجماعة، وفى محاولة لتصفية الجو بعد ذلك وضع الإخوان المسلمون شرطا لتأييدهم للثورة، وهو أن يعرض مجلس قيادة الثورة عليهم جميع قراراته، لأخذ رأيهم فى مدى مطابقتها لدين الله الحنيف، وأنهم مكتفون بذلك وغير طامحين إلى الاشتراك فى الحكم، فالطموح الدنيوى ليس هدفا من أهداف رجال الدعوة، والقيام بأعباء الحكم ليس واردا فى برنامجهم، لأنهم كانوا وسوف يستمرون، جماعة وليسوا حزبا".

وفى هذه النقطة يثنى فرج فودة على رجال الثورة وجمال عبد الناصر أنهم لم يقبلوا العروض السياسية من جماعة الإخوان، وفرض وصايتهم على ثورة يوليو، مما أحدث صدامات يعرفها الجميع بين سلطة يوليو وجماعة الإخوان، تلك الصدامات لم تكن صدامات خفيفة، بل وصلت إلى حدود دموية، بعدما حاولت جماعة الإخوان التدبير لاغتيال جمال عبد الناصر فى أكتوبر 1954، مما أطلق عليه "حادث المنشية" فى مدينة الإسكندرية، وتم الصدام لصالح السلطة بالطبع، وطوردت الجماعة بكل السبل فى ذلك الوقت، وتم الحكم على سبع من القيادات بحكم الإعدام، منهم المرشد حسن الهضيبى، والذى تم تخفيف الحكم بالمؤبد، ثم بالإفراج عنه، بعدها ظلّت جماعة الإخوان بعيدة تماما عن الساحة السياسية حتى أعادهم السادات إلى الحياة السياسية والاجتماعية والإعلامية بعد أن تولى الحكم عام 1970 بعد رحيل جمال عبد الناصر.
ورغم أن كثيرين كتبوا عن العلاقة الشائكة والمعقدة بين قيادة الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين باستفاضة ومن وجهات نظر متباينة كما أسلفنا، إلا أننا نريد أن نورد وجهة نظر أحد المفكرين الكبار، وهو الدكتور فؤاد زكريا فى كتابه "الحقيقة والوهم فى الحركة الإسلامية المعاصرة" الصادر عن دار الفكر عام 1986، وهى وجهة نظر لا تختلف كثيرا عن ما ذهب إليه د فرج فودة، ولكن الدكتور زكريا أراد أن يعمّقها، ويضع النقاط على الحروف العارية، فأوضح بأن الخلاف الذى كان يقع دائما بين الجماعة وقيادة ثورة يوليو، هو خلاف سياسى فى الأساس، وليس خلافا دينيا إطلاقا، فالجماعة كانت تزعم دائما بأن رجال الثورة يريدون تشويه الدين الإسلامى، على اعتبار أنهم هم الدين الإسلامى، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ولكنهم كانوا يريدون بإشاعة تلك القصة من أجل كسب التعاطف داخليا وخارجيا، ومن الطبيعى أن يجدوا بعض المتعاطفين بالفعل، وهذا ما حدث فى صدام 1954، وكذلك فى صدام 1965، ويمدّ زكريا وجهة نظره على آخرها، فيعتبر أن الصدامات بين الإخوان والثورة تنبع من فكرة أنهما شبيهان، فالديمقراطية تكاد تكون معدومة بين الطرفين، لذلك العلاقة بينهما دائما كانت حدية، فلا وسط فى علاقتهما، إما علاقة دموية، وإما العكس، ويرى كذلك أن السلطة الناصرية لم تسع لتشويه الدين الإسلامى كما زعمت جماعة الإخوان المسلمين، بل يرى زكريا بأن الاهتمام بالشأن الدينى كان موجودا فى عهد ثورة يوليو، أكثر مما كان قائما فى ما قبلها، ويكفى على ذلك دليلا _كما يرصد فؤاد زكريا_ إنشاء مؤسسات كالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذى كان يصدر بانتظام عددا كبيرا من الكتب والمجلات الدورية، وكان له نشاط واسع فى كافة المناطق التى تحتاج فيها الدعوة الإسلامية إلى رعاية وخاصة فى أفريقيا والشرق الأقصى وهكذا.
ويورد فؤاد زكريا تلك المعلومات دون أن يذكر لنا المجلات التى كانت تصدر قبل ثورة يوليو، ولا يرصد دليلا على قلتها، فهى كانت كثيرة كما أزعم، ويكفى أن مجلات جماعة الإخوان المسلمين المتنوعة كانت تصدر بغزارة، وما النشاط الإعلامى الدينى الذى أتى من قبل الدولة، إلا محاولة للسيطرة على أمور الدعوة خارج البلاد وداخلها، وتحجيم نشاط جماعة الإخوان المسلمين، أى أن الصراع كان كذلك سياسيا وليس دينيا، كل طرف كان يريد فرض وجهة نظره بالطرق التى يملكها، وعدم ترك المجال للجماعة وغيرها من الجماعات المتطرفة، والتى كانت مازالت نويات منبثقة عن التنظيم الأم، وهو تنظيم الأخوان المسلمين.
الناصريون ليسوا جمال عبد الناصر:
وكان فودة دائما ما يرد على بعض وجهات النظر التى تفرضها الأحداث فى المجال السياسى، وعلى سبيل المثال وجه بعض الانتقادات فى مقال عنوانه "عبد الناصر" نشره فى جريدة مايو أكتوبر 1990، وهو انتقاد للناصريين، أكثر ماكان انتقادا لجمال عبد الناصر، وبالطبع وردت بعض الهمزات واللمزات من خلال بعض ملاحظاته على السلوك الذى سلكه الناصريون إزاء احتلال صدام حسين لدولة الكويت فى أكتوبر عام 1990، وكان الناصريون منحازين بشكل واضح إلى الزعيم صدام حسين، ومن ثم يذهب فرج فودة إلى توجيه نقد حاد: "الناصريون أصحاب أعلى الأصوات دفاعا عن القومية العربية، والوحدة العربية والتكامل العربى، وأصحاب الأغانى الرنانة، من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر، قفزوا فى خفة عجيبة فوق مأساة دولة عربية، تقع على الخليج (الثائر) كان اسمها (الكويت)، لم تشفع عضويتها فى جامعة الدول العربية، ولا مساندتها للنضال الناصرى بعد (النكسة)، ولا صحافتها التى كانت فى وقت من الأوقات أعلى المنابر صوتا فى الدفاع عن العرب والعروبة، وكشفوا لنا أنهم يفهمون الناصرية على أنها فلسفة ضرب الرأس فى المحيط، والعداء للأمريكان حتى الموت....".
ويستطرد فودة فى سرد بعض الظواهر التى يراها فى الناصريين، ويعقد مقارنة بينهم وبين الجماعات الإسلامية، فالناصريون _كما يرى_ يريدون منا أن نعود لزمن الخمسينات والستينات، كما أن الجماعات المتطرفة يريدوننا أن نعود لزمن الهجرة، ويعترف فودة بأنه اقترب من بعض القيادات الناصرية، على سبيل المثال شعراوى جمعة_الذى كان وزيرا للداخلية فى أواخر عهد عبد الناصر_ بعد أن زالت عنه الأضواء، ويصفه بالموضوعية والحكمة، كما أنه اقترب من هيكل _كما يكتب_، ولكنه لم ير أويسمع منه ما كان يقوله "الناصريون" الجدد، ويبدو من الاستطراد أن فرج فودة لا يوجه النقد الحاد إلى جمال عبد الناصر، بقدر ما يوجهه إلى الناصريين الجدد، الذين رفعوا "قميص" عبد الناصر كما كان يردد الرئيس أنور السادات دائما.
وشهد شاهد من أهلهم:
ولا يكتب فرج فودة كتابا، إلا ويتعرض فيه للماضى القريب، خاصة ثورة يوليو وجمال عبد الناصر، وعلاقتهما بجماعة الأخوان المسلمين، وورد هذا فى كتابه "الحقيقة الغائبة"، وفى كتابه "الإرهاب"، ففى ذلك الكتاب الأخير يتعرض فودة إلى نشأة الإرهاب فى مصر، وذلك منذ إنشاء ما يسمى بالتنظيم السرى فى جماعة الأخوان المسلمين، ويذكر أن كثيرا من أعضاء الجماعة خرجوا من السجون والمعتقلات، وبعدها خلعوا الجبة والعمامة والقفطان، وانطلقوا بالملابس الأفرنجية، يلقون الخطب الرنانة فى المناسبات القومية، ويلعنون أخوان الشياطين، وينشدون الأشعار الثورية، وبهذه الأمور يمارسون تقنية التقية المعتادة عندهم، ويقول فودة: "وأذكر أن صديقا يعرف تاريخ أحدهم القديم، داعبه بسؤال لئيم، عما يفعله لو عاد عبد الناصر من الموت، فأجابه ببديهة حاضرة، ودعابة ساخرة : سألزم السكوت، وأرتدى الردنجوت"!، ويستدرك فرج فودة ليعلن أنه لا يبارك التعذيب، أو التنكيل السياسى بالخصوم، ولكنه يعرض للحالة التى كانت قائمة بين جمال عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلمين.
وفى سياق آخر، يكتب فرج فودة مقالا عن أنور الجندى فى جريدة مايو بتاريخ 11 ديسمبر 1989، ذلك الرجل الذى تحول من مديح جمال عبد الناصر، إلى الهجوم عليه بضراوة، كما أنه كتب مقالا له يقدح فى جماعة الإخوان التى ناصرها فيما بعد، وكان المقال منشورا فى كتاب أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 1965، وكان عنوانه "رأى الدين فى إخوان الشياطين"، هذا الرجل نفسه "أنور الجندى" أصبح نجما فى مجلة المختار الإسلامى، وصحيفة النور، وجميع مقالاته فى هذين المصدرين كما يقول فودة "مقالات تندد بالحكم المدنى والقوانين الوضعية والعلمانية، وتناصر التيارات السياسية الدينية، وقبلها أصدر كتبا هاجم فيها الدكتور طه حسين"، والمفاجأة التى يعلنها فرج فودة لقرائه، هى أن الأستاذ أنور الجندى كان قد كتب كتابا كاملا عن جمال عبد الناصر فى فترة صعوده عام 1956، وكان عنوانه "جمال عبد الناصر والثورة"، وفى نبرة ساخرة ومستهجنة يكتب فرج فودة: "..والرجل أطال الله فى عمره معجب كل الإعجاب بحرية الفكر والتعبير فى عهد الرئيس عبد الناصر، وهو معجب أكثر بوحدة الفكر التى لا تعترف بالأحزاب أو التكتلات حيث يقول لا فض فوه : ولقد أتيح لفكرنا فى ظل حياتنا الجديدة بعد الثورة أن يكون قادرا على إتاحة الفرصة للكلمة مادامت تصدر عن إخلاص وصدق وإيمان وإيجابية، وما دامت بعيدة عن الحقد، وفى ظل وحدة الفكر التى يصنعها اليوم الالتقاء الكامل بغير أحزاب أو تكتلات تجد الكلمة الإيجابية مجالها ومسارها"!
وهكذا يكشف فرج فودة الأوراق المتناقضة لأحد المتطرفين الجدد، والذين قادوا حملة شرسة ضد التنوير وجمال عبد الناصر، وفى لفتة فودة الذكية، راح يقارن بين الهجوم على جمال عبد الناصر، والهجوم على الدكتور طه حسين، وذلك فى الكتاب الذى أصدرته دار الاعتصام لأنور الجندى عام 1976 تحت عنوان "طه حسين .. حياته وفكره فى ميزان الإسلام"، وراح_أى الجندى_ يسرد سلسلة من الأفكار التى تجعل من طه حسين ملحدا وكافرا، بعدما كان يمدحه فى مجلات وصحف كثيرة فى عقدى الخمسينات والستينات، وهكذا كشف فرج فودة عن تلك التناقضات الحادة التى يقع فيها المتطرفون، بين عهدين مختلفين، ويورد كتابات أنور الجندى وهو أحد أبرز مفكرى الإسلاميين الجدد فى عقد السبعينات، ونلاحظ أن الكتاب المنشور عن د طه حسين، نشر عام 1976، أى فى العام نفسه التى عادت مجلة الدعوة للظهور، وكذلك عن دار تخصصت فى نشر كل الكتب التى هادمت التنوير بضراوة، وفى نهاية مقاله، يقول فرج فودة بنبرة متهكمة: "..دعوتى إلى أن تحصل كل التيارات السياسية على حقها فى التواجد والتعبير، فإن من حقه علىّ أن أحترم آراءه فى رفض التعدد الحزبى، وفى الهجوم العنيف على من أسماهم الكتاب بإخوان الشياطين، وفى الإيمان العميق بفلسفة الثورة والميثاق والاتحاد الاشتراكى، وأن أشد على يديه ككاتب ناصرى لا يشق له غبار، وفارس من فرسان الثورة الأبرار، وعدوا لأخوان الشياطين، الذين خلطوا أوراق السياسة بأوراق الدين، وعجزوا عن فهم حركة التاريخ، فروعوا الآمنين، مرحبا بالكاتب التقدمى الثورى الناصرى الميثاقى الاتحادى الأمين".
وفى سياق منفصل متصل، يثنى فرج فودة على جمال عبد الناصر فى وعيه بخطورة جماعة الإخوان، وذلك فى مقارنة بين الرئيسين "السادات وناصر"، السادات الذى لم ينصت لتقارير المخابرات التى كانت تبلغه بأن جماعات التطرف تعمل على اغتياله، فلم يصدقهم، وظل على تعاون بشكل ما معهم، وفى آخر لحظات حياته، وكان مضرجا فى دمه بفعل رصاصاتهم، صرخ بحسرة وربما بحزن وربما فى دهشة "مش معقول مش معقول"، وكانت هذه آخر كلماته، وكأنها النهاية الأبدية للعلاقات المضطربة سياسيا، أما جمال عبد الناصر كان أكثر إدراكا، وربما أكثر حظا، إذ يكتب فودة فى مقال نشره فى جريدة مايو أكتوبر عام 1990 قائلا: "..لم يشفع هذا كله لعبد الناصر أمام الإخوان المسلمين، فانطلق الرصاص فى المنشية مستهدفا اغتياله، وتناثرت العبارات المنطقية وغير المنطقية على شفتيه، وهى عبارات يمكن إيجازها فى تعبير (مش معقول)، نعم كان عبد الناصر محظوظا حين نجا من الاغتيال وحين أتاحت له هذه النجاة أن يستوعب الدرس، وأن يفهم فلسفة تيار لم يتخل أبدا عن منهجه وهو عض اليد التى تمتد إليه بالمساعدة وقتل النفس التى تسعى إليه بالتأييد وهدم النظام الذى يتيح له خرية التعبير والتواجد".
أزعم أن الدكتور فرج فودة لم يتخلّ عن نظرته الموضوعية لجمال عبد الناصر فى كافة الملابسات السياسية التى حدثت فى عهده، ولم يمالئ تيارا أو قائدا أو حزبا أو فلسفة، ولكنه كان يعالج كافة القضايا السياسية المعاصر لها، والقضايا التى سبقت، فى إطار علاقة السلطة السياسية بجماعات التطرف، وهو فى هذا الإطار كان يرى جمال عبد الناصر حاسما وحازما وهاضما للدرس الذى تلقاه مبكرا، وبالتالى لم تحدث كوارث طائفية واضحة فى خلال فترة حكمه، ربما كانت تلك الكوارث مؤممة، وكامنة، ومكبوتة، ولذلك انفجرت بعد رحيله بشكل كبير ومدوى، ربما ينتصر فرج فودة لليد الحديدية التى كانت تقبض على كافة الأمور، ولكن هذه اليد الحديدية ذاتها، لم تستطع أن تمحو الأفكار المتطرفة بشكل نهائى، وربما تكون وجهة نظر فؤاد زكريا التى تقول بأن الصدام بين سلطة يوليو وجماعة الإخوان المسلمين يعود إلى أن الطرفين لم يعرفا الديمقراطية، وأن الطرفين لم يهادنا أو يساوما على أى مساحة من الأفكار، ولذا كان الصدام عنيفا ودمويا، وبالتالى _حسب زكريا_ لم توجد تلك العلاقة الوسطية.
ولا تريد هذه السطور أن تنتهى، وربما حاولت أن أعالج جانبا غير مطروق بتوسع فى الجانب السياسى عند فرج فودة، وهو جانب لا ينفصل بأى حال من الأحوال بمجمل كتاباته الصدامية، والتى عملت على فضح التناقضات الحادة فى خطاب المتطرفين الجدد، والذين أصبحوا أكثر ضراوة وشراسة مما سبق، ربما كان فرج فودة ينشد عدم التهادن أو التهاون مع تلك الجماعات لخطورة تأثيرها، وهذا الحسم من وجهة نظر فرج فودة، هو الذى جعله يكتب برفق كلما أتت سيرة جمال عبد الناصر، ورغم ذلك، دفع فرج فودة حياته كلها ثمنا لأفكاره السياسية والاجتماعية، لأنه كان مصدر إزعاج لتلك التيارات الإرهابية حتى الآن، رغم أن عمر نشاطه الفكرى لم يتجاوز تسعة أعوام، وذلك منذ أن أصدر كتابه الأول "الوفد والمستقبل"، إلى حادثة اغتياله فى 8 يونيو 1992.