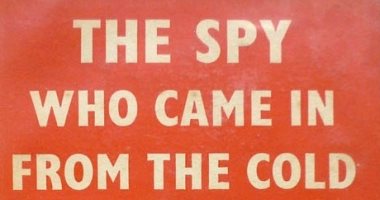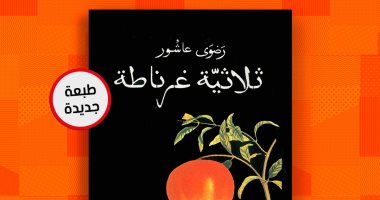محمود الوردانى أحد أهم كتاب جيل السبعينيات، ولد فى الأول من يناير عام 1950 بحى شبرا فى القاهرة، وتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية عام 1972، وشارك فى حرب أكتوبر، وكان أحد مؤسسى صحيفة أخبار الأدب، وترجمت بعض قصصه القصيرة للإنجليزية والفرنسية، بدأ رحلته بقصة قصيرة نشرت فى جريدة المساء عام 1968، وكان عمره وقتها سبعة عشر عاما، ثم توالى إنتاجه، فأصدر عددا من الروايات والمجموعات القصصية القصيرة، أبرزها: السير فى الحديقة ليلًا عام 1984، نوبة رجوع 1990، رائحة البرتقال عام 1992، الروض العاطر عام 1993، النجوم العالية عام 1985، فى الظل والشمس عام 1995، طعم الحريق عام 1995، أوان القطاف عام 2002، موسيقى المول عام 2007، الحفل الصباحى 2008، بيت النار 2012، البحث عن دينا 2016، باب الخيمة 2018، صمت الرمال 2018، وحصل على عدد من الجوائز، منها الجائزة الأولى فى فرع الرواية لكبار الكتاب فى مسابقة ساويرس الثقافية لعام 2013 عن روايته "بيت النار".
و"اليوم السابع" التقى الكاتب الكبير وحاوره حول العديد من القضايا العامة المعنية بالشأن الثقافى ككل والقضايا الخاصة بسيرته الذاتية وإنتاجه الأدبى.. إلى الحوار:
ـ صدر لك عدد كبير من الأعمال السردية وفصول السيرة التي هي خليط من الهمين: الهم العام والهم الخاص، وربما كان أحدث إصداراتك من النوع الأول روايتك: "ساعات الأسر"، ومن النوع الثانى: "الإمساك بالقمر"، فهل تتأهب لكتابة جديدة.
لأ.. أنا لم أتجرأ على كتابة جديدة بعد روايتى التى صدرت هذا العام، فأنا فى العادة أجلس للاستيعاب والتأمل عقب وضعى للقلم، وقبل معاودة الإمساك به ثانية، كما أننى لست من النوع الذى تتزاحم مشاريع الكتابة فى رأسه، ولا أؤجل فكرة أو أرجئ مضمونا دون أن أفرغه على الورق.
ـ فى فترة التأمل هذه هل تقرأ نفسك.. أعنى.. هل تعيد قراءة بعض أعمالك؟
لأ.. من النادر أن يحدث ذلك
ـ بعض الكتاب يؤمنون بأن الكتابة تغير العالم ولكن ببطء.. وبعضهم الآخر يعتقد بأنها لا تفعل شيئا سوى مداوة نفس الأديب بـ"البوح والتعبير".. بعد عمر من الكتابة.. نسألك عن جدواها؟
جدوى الكتابة بالنسبة لى ليست مباشرة، بمعنى إننى شخصيا أحب الكتابة، وأتحقق عندما أكتب، نعم.. أتحصل على الراحة والبهجة والسعادة بشكل لن أحصل عليه من أى ممارسة أخرى، بالتأكيد هى تغير العالم ببطء وعلى المدى البعيد، لكن أنا لا أستطيع الاستغناء عن الكتابة، الكتابة هى أنا، فعدم الكتابة يعنى عدمى.
فى ضوء كثرة الجوائز المرصودة للأدب أصبح واقع المثقف المصرى كاتبا كان أو ناقدا موزعا بين المؤتمرات والمهرجانات والندوات، وأصبح التعاطى مع الأعمال الجادة أو الحقيقية تعاطٍ سطحى هذا إن وجد من الأساس، ما يعنى ظلم عدد كبير من الكتاب ومن ثمّ ضمور أيديهم.. فى رأيك كيف يمكن التعافى من هذا الوضع؟
أنا كتبت فى موضوع الجوائز مقالين، الأول انتقدت فيه تحول الجوائز إلى عقبة فى طريق الكتابة، فهى تعطى غرورا واستعلاء للكاتب، كما لو كانت "سلطانية" تم تتويجه بها، ولهذا فالجوائز وحدها لا تكفى، بل يجب أن توازيها حركة نقدية نشطة وحركة ترجمة وحركة صحافة ثقافية وندوات ومؤتمرات، أما الجوائز فقط وبهذا الشكل الذى يخلق تنافسا على الكتابة بين الكتاب فلا أظنه أمرا صحيا، المفروض أن تكون هناك حركة ثقافية وأن تكون الجائزة جزءًا منها، وعندك محمد المخزنجى مثلا، يرفض التقدم لأى جائزة بلا استثناء، والجائزة الوحيدة التى حصل عليها، كانت اللجنة هى التى منحتها له دون أن يترشح هو لها.
تقصد أن أزمة الجوائز هى أزمة كتّاب وليس لجان تحكيم متهمة بالشللية ومراعاة معايير أخرى ليس من بينها الإبداع؟
هذا الكلام قد يكون صحيحا، ولكن المخزنجى مثلا، قال لى: كيف أدخل منافسة على الكتابة!!.. وبالتالى مشكلة الجوائز هى مجموع ما قلناه وهو يرتد فى النهاية للمناخ الثقافى العام.
ـ هل تتابع الجديد فى عالم السرد؟.. وبالأخص الرواية في مصر والأقطار العربية؟.. وهل شدك كاتب أو أكثر؟.. وكيف تقدم دعمك واعترافك لمن يستحقه؟
نعم بالتأكيد، هذا هو الهم الذى يشغلنى، وأحب أن أتابع أغلب الإنتاج الجديد على المستوى المحلى أكثر من العربى، ربما لأن الإنتاج المحلى هو ماتطوله يدى، وأنا أكتب عن هؤلاء.. منهم مثلا: هبة خميس ورواية مساكن الأمريكان وأحمد كامل فى جبل المجازات وغيرهم.
قرأت لك بعض الكتابات النقدية، ومنها تقديمك لرواية "ليل مدريد" لسيد البحراوى، كان أسلوبك دسما ومكتنزا وقويا للغاية ورغم قصر المقال إلا أنه أتى على العمل ونجح فى إبرازه وترشيحه للقارئ، ألا تنوى أن تجمع هذه المقالات فى كتاب نقدى؟
نعم.. هذا الموضوع يشغلنى.. أريد بالفعل أن أتوفر على ما كتبته من مقالات نقدية وأيضا دراسات مهمة ولعدد كبير من رموز الثقافة فى مصر، منهم أروى صالح فى ذكراها ووجيه غالى، وليس فقط بخصوص الرواية ولكن أمور أخرى، منها مثلا مذكرات حزب العمال الشيوعى المصرى.. نعم عندى إنتاج وفير ولكن لا أستطيع لأسباب أغلبها تقنى أن أتوفر عليها.
ـ هذا يعنى أنك تفكر فى إصدار دراساتك النقدية الخاصة بالرواية؟
ليس بالضبط.. هذا يعنى فقط أننى أريد أن أجمع كل هذا الذى كتبته ليكون أمامى، لأنه يخيل إلىّ أن لدى كتابات تشكل امتدادا لكتاب "الإمساك بالقمر" لأن هذا الكتاب متوقف عند "حبسة عام 82"، ومن هذه الحبسة وحتى الآن جرت فى النهر مياه كثيرة، وبالتالى لو أمسكت بهذه الكتابات لصنعت سياقا ونسقا يمتد بعد الإمساك بالقمر فى جزئه الأول، لكن عدم توفر هذه الكتابات إلى جانب بعض المشاكل الصحية تجعلنى متوقف عن هذا الآن.
ـ لكن أنتم أصحاب المصلحة الأولى.. ألا يجدر بكم تبنى الدعوة لجمع هذا التراث وميكنته؟
ابنة يحيى الطاهر توافق جدا على هذه الميكنة لتراث أبيها وهشام ابن إبراهيم أصلان، وعبده جبير الذى يحتفظ بكل ما كتب عنه وغيرهم، لأن الطريق الوحيد لحماية أى شىء هو رقمنته، لأن هذا جزء من تاريخ الأمة، وأنا أؤيد هذه الدعوة بشدة.
ـ نعود للإمساك بالقمر.. لماذا "الإمساك بالقمر"؟.. أعنى أن المعنى ـ من الناحية الواقعية ـ مستحيل.. ومن ثمّ هل هو عنوان يائس لكتاب يؤرخ لوطن مبتسر، يفتقر لأسباب الحياة الصحية على مستوياتها المختلفة، اللهم إلا ذهنيا في أحلام اليقظة، خاصة أن تاريخك هو سلسة من الآمال الكبيرة والإحباطات الأكبر.. هل آلت بك كل الانكسارات إلى التسليم باستحالة الإصلاح/ الإمساك بالقمر؟
لأ.. هذا الربط متعسف.. على العكس.. كان العنوان تفاؤليا.. وهذا لأن هذا الكتاب يؤرخ لاعتصام ألف طالب بجامعة القاهرة فى عام 72، فعندما كنا ننتخب اللجنة الوطنية العاليا شعرت بأنى قادر على الإمساك بالقمر، وجود هذا الجمع بهذه المشاعر الوطنية المتدفقة الدافئة وهذا الاستعداد للبذل والعطاء من أجل القضية الوطنية ودون مقابل من شبان وشبات عشرينيين مثّل بالنسبة لى هزة وجدانية عنيفة، أما كون الأحلام لا تتحقق فهذا لا يعنى أن نكف عن الحلم.. إطلاقا.. سنظل نحلم حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.
بعض المثقفين يحلو لهم جلد الذات واتهامهم أنفسهم ـ كنخبة ـ بالعزلة والاستعلاء، ما يلقى عليهم جزء من المسئولة عن التراجع الثقافى، هل ترى أن المثقفين ـ بالفعل ـ جزء من المشكلة وليس الحل؟
لا.. رغم أننى أقر بعزلة العدد الأكبر من المثقفين، وبأنهم بالفعل منسحبين من معترك الحياة، ولكن قد يكون المناخ العام غير مساعد، اليوم لا توجد مطبوعة ثقافية واحدة تحترم القارئ.
ـ ننتقل إلى فكرة المجايلة والجدل الدائر حولها، وهى فكرة تنطوى على بعض الارتباك، فبعض النقاد يرون أحد الكتاب سبعينى (من جيل السبعينيات) ونقاد آخرون يرونه ستينى (من جيل السينيات)، مثل إبراهيم عبد المجيد مثلا، كيف ترى هذه الفكرة؟
أنا لى وجهة نظر فى هذا الموضوع وهى أن جيل الستينيات هو الذى ابتكر ـ تقريبا ـ الرواية الجديدة واستخدم تقنيات السرد بشكل مغاير، هذا على مستوى الشكل أما على مستوى المضمون فقد أثر عليهم أكبر حدث مزلزل في تاريخنا المعاصر وهو نكسة 1967، وفى نفس العقد حدثت ثورة الطلبة فى سنة 1968، وانفجار كونى بحركات الهيبز وثورة الشباب، فجيال الـ 60 هو الذى حطم كل القوالب، ونجيب محفوظ قلد هذا الجيل فى قصته الشهيرة "تحت المظلة"، ومن ثمّ فلهذا الجيل فضل في كسره لأساليب السرد، وكذلك الشعر والمسرح وسائر الفنون، ففى تقديرى أن ما تلا هؤلاء ليسوا أجيلا جديدة وإنما موجات مختلفة، وهى موجات لها أهميتها الشديدة، وحتى آخر كاتب قرأت له، مثل: محمد حمامة وأحمد كامل وغيرهما، فهؤلاء كلهم إضافات على المتن الذى أرساه جيل الستينيات.
ـ لكن أنت فصلت ـ في رأى سابق لك ـ بين الرواية الستينية والرواية التى تلت ثورة يناير 2011، وقلت أن ما سيلى الثورة سيكون نسقا جديدا مختلفا لم تتضح معالمه حتى الآن.
نعم.. وهذا غير متناقض.. وأنا بالفعل كنت متفائلا جدا بالثورة المجيدة.. لكن الأجيال الجديدة لم تأخذ فرصتها بعد
ـ هل يعنى ذلك أن الرواية المصرية منذ الستينيات حتى الآن تسير فى مساراتها الثلاث الرئيسية، مسار التاريخ ومسار التراث الشعبى والفلكلور وأخيرا مسار تعميق الواقعية، ألم تستوفِ الرواية هذه الاتجاهات وبالتالى آن الأوان لابتكار مسارات جديدة؟
على العكس.. هذه الاتجاهات لم تستوفِ مضامينها بعد، وأزعم أن بعض جوانبها لم تكتب من الأساس، وأنها مازلت أرضا خصبة يمكن إنبات أعمال عظيمة منها.
ـ فى ظل انفرد مصر بالعديد من الخصائص الإنثروبولوجية والثقافية التى تميزها عن محيطها الإقليمى، هل تؤمن بتمايز الرواية المصرية باعتبار أن الأدب يستقى من واقع مجتمعه ويعبر عنه وعن سماته، أم أن الحديث عن أى تمايز ـ وليس تميز ـ على أسس قطرية هو حديث باهت فى ظل وحدة اللغة وأساليب السرد؟
ظنى أن هذا التمايز فى التوقيت الحالى غير ملاحظ بشكل قوى، قد يكون موجودا بقوة أيام نجيب محفوظ، فقد كانت مصر دولة فتية وأدبها محلى وعالمى معا، فى الحين الذى كانت فيه أغلب دول المنطقة بلا قامات أدبية كبيرة وبلا بيئات مشابهة للبيئة المصرية أو للمدنية المصرية، أما الآن فالأوضاع اقتربت من بعضها، الأمر الذى يبهت أى فوارق، على سبيل المثال عندما أقرأ "النبيذة" لـ"إنعام كاجه جى" أشعر أنها عمل متميز وقريب من كتاب مصريين مثلما هو قريب من كتاب غير مصريين، الآن هناك كتاب سعوديين مثل: محمد حسن علوان وعزيز محمد لا يمكن أن تتنبأ بجنسياتهم، يكتبون بلغة مشتركة ويعبرون عن هموم قريبة، وهناك الكاتب الكويتى سعود السنعوسى، قرأت له "ساق البامبو" وكانت رواية جميلة جدا، ما أقصده إن الفوارق المحلية نعم موجودة، لكنها غير قادرة على صنع الفواصل، بالعكس هى شىء إيجابى لأنها تعكس التنوع، وهذه هى عبقرية نجيب محفوظ، فهو كاتب محلى جدا، ومع ذلك وصل للعالمية، أى أنه انطلق من المحلية للعالمية.
ـ بمناسبة نجيب محفوظ.. كانت علاقتك به في البداية فاترة، وكنت تعتبره "كاتبا تقليديا" ثم انقلبت هذه النظرة تماما، ما السبب؟
هذا حقيقى.. في البداية لم أرَ في أعماله التاريخية الأولى أي نبوغ خاص، أو قدرة غير عادية، لكن بدءا من الحرافيش اضطررت إلى إعادة النظر في هذا الرجل لأكتشف أنه "حاجة تانية"، فالذى يبدأ بالروايات التاريخية وينتهى بـ"أصداء السيرة الذاتية" و"أحلام فترة النقاهة"، هو شخص فذ، قطع مسافة أسطورية، هو بالفعل كاتب مختلف ومحترف، لم يفعل شيئا فى حياته سوى الكتابة، أخلص لها فأخلصت له، رغم أن الأدب لا يُعيل صاحبه، وهو لم يكن يأخذ من رواياته إلا ملاليم قليلة، وقد حضرته فى مقهى ريش ذات مرة سنة 69 وسمعته يقول وهو يضحك أنه ينفق على الكتابة من جيبه.. نعم.. كان منتبها لهذا وقانعًا به، فلم يحقق فى حياته غير الكتابة، لكنه حققها بصدق فحققته فى المقابل