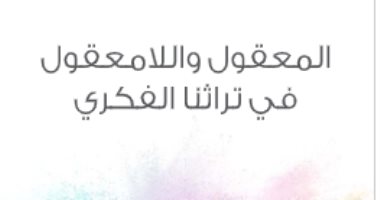نواصل سلسلة مقدمات الكتب ونتوقف اليوم عند كتاب "المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري" للمفكر الفيلسوف زكي نجيب محمود، فما الذي يقوله فيه:
يقول الدكتور زكي نجيب محمود تحت عنوان "مقدمة":
كنتُ في كتابي "تجديد الفكر العربي" قد طرَحتُ هذا السؤال: كيف السبيل إلى ثقافة نعيشها اليوم، بحيث تجتمع فيها ثقافتنا الموروثة مع ثقافة هذا العصر الذي نحياه؛ شريطةَ ألا يأتيَ هذا الاجتماع بين الثقافتَين تجاورًا بين مُتنافِرَين، بل يأتي تضافرًا تُنسَج فيه خيوط الموروث مع خيوط العصر نَسْج اللُّحمة والسَّدى؟ ثم حاولتُ أن أُقدِّم عن هذا السؤال جوابًا، إلا يَكُن هو الجواب القاطع، فلا أقلَّ مِن أن يَكون جوابًا مُحتمِل الصواب؛ لعله يُثير الفكر عند آخرين، فيُصحِّحونه ويُكلِّمونه، وكان جوابي عندئذٍ هو أن نأخذ عن الأقدَمين وِجهات النظر بعد تجريدها من مشكلاتهم الخاصة التي جعَلوها موضع البحث؛ وذلك لأنه يبعد جدًّا — لتطاول الزمن بيننا وبينهم — أن تكون مُشكِلاتُ حياتنا اليوم هي نفسها مُشكِلاتهم، وإذن لم يَعُد يُجدي أن أحصر بحثي في مشكلاتهم التي طُوِيَت موضوعاتها طيًّا، ولكن الذي قد يَعود علينا بالنفع العظيم، من حيث الحفاظُ على كيانٍ لنا عربيِّ الخصائص، هو أن ننظر إلى الأمور بمثلِ ما نظروا، أو قُل بعبارة أخرى: أن نحتكم في حُلولنا لمُشكِلاتنا إلى المعايير نفسِها التي كانوا قد احتكَموا هم إليها.
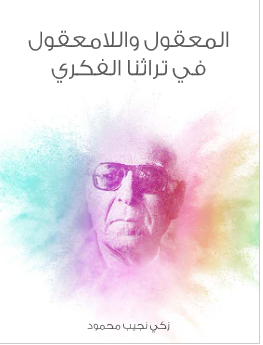
المعقول واللامعقول
ولقد زعَمتُ في محاولتي تلك أن النظرة العقلية، برغم اختلاطها بكثيرٍ جدًّا من عناصر اللاعقل، كان لها شيءٌ من الظهور عند آبائنا من العرب الأقدمين؛ بمعنى أنهم كلما صادفَتْهم مشكلة جماعية الْتمَسوا لحلها طريقةَ المنطق العقلي في الوصول إلى النتائج، وكادَت النَّزعة اللاعقلية العاطفية عندهم أن تَقتصر على الحياة الخاصة للأفراد؛ فلقد كانت لهم في طرائق العيش الاجتماعي «حكمة» — والحكمة إنما هي نظرة عقلية مكثَّفة — وما زِلنا إلى يومنا هذا نرتدُّ إلى حِكمتهم هذه، فتَرِد على ألسنتنا — من مَحفوظنا — روائعُ مما قالوه في ذلك شعرًا ونثرًا، وكأننا كلما نطَقْنا برائعة من تلك الروائع قد أسرَجْنا مِصباحًا يناسب الموقف المعتِم الذي أحاط بنا، فنهتدي في مواجهته إلى طريق؛ نعَم قد كان لهم إلى جانب نظراتهم المعقولة العاقلة شطحاتٌ للوجدان، لكنَّ جانبًا من هذَين لا ينفي جانبًا.
وقد أردتُ بهذا الكتاب الذي بين يدَيك أن أقف مع الأسلاف — في نظراتهم العقلية وفي شطحاتهم اللاعقلية كِلَيهما — فأقف معهم عند لقطات ألقطها من حياتهم الثقافية؛ لأرى: مِن أي نوع كانت مشكلاتهم الفكرية، وكيف الْتمَسوا لها الحلول، لكنني إذ فعلتُ ذلك، لم أحاول أن أُعاصرهم وأتقمَّص أرواحهم لأرى بعيونهم وأُحِسَّ بقلوبهم، بل آثرتُ لنفسي أن أحتفظَ بعصري وثقافتي، ثم أستمع إليهم كأنني الزائر جلس صامتًا لِيُنصِت إلى ما يدور حوله من نقاش، ثم يُدْلي فيه بعد ذلك — لنفسه ولمعاصريه — برأيٍ يَقبل به هذا ويَرفض ذاك.
قسمتُ الكتاب قسمَين: جعلت أحدَهما لرحلتي على طريق العقل عندهم، وجعلتُ الآخرَ لبعض ما رأيتُه عندهم مجافيًا للعقل، لائذًا بما ظنوه أعلى منه، وتعمدتُ أن يجيء القسم الأول أكبرَ القِسمَين؛ لتكون النسبة بين الحجمَين دالةً بذاتها على النسبة التي أراها واقعة في حياتهم الفعلية بين ما وزَنوه بميزان العقل وما تركوه لشطحة الوجدان.
ولقد اهتديتُ في رحلتي على طريق العقل بدرجات الإدراك في صعودها من البسيط إلى المركَّب، وهي المراحل التي أشار إليها الغَزاليُّ عند تأويله لآية النور: فالمشكاة، والمصباح، والزجاجة، والزيتونة هي عنده درجاتٌ مِن الوعي، تتصاعد وتزداد كشفًا ونَفاذًا، فاستخدمتُ بدَوري هذه المراحل لأرى من خلالها خمسة قرون من تاريخ الفكر في المشرق العربي — من القرن السابع الميلادي إلى بداية القرن الثاني عشر — إذ خُيِّل إليَّ أن السابع قد رأى الأمور رؤيةَ المشكاة، والثامن قد رآها رؤية المصباح، والتاسع والعاشر قد رأَيَاها رؤية الزجاجة التي كانت كأنها الكوكب الدُّري، ثم رآها الحادي عشَر رؤية الشجرة المباركة التي تُضيء بذاتها.
وذلك لأني قد رأيتُ أهل القرن السابع وكأنهم يُعالجون شئونهم بفطرة البديهة، وأهل القرن الثامن وقد أخَذوا يضَعون القواعد، وأهل القرنين التاسع والعاشر وقد صَعِدوا من القواعد المتفرقة إلى المبادئ الشاملة التي تضمُّ الأشتاتَ في جذوع واحدة، ثم جاء الحادي عشر بنظرة المتصوِّف التي تَنطوي إلى دخيلة الذات من باطن؛ لترى فيها الحقَّ رؤية مباشرة.
كذلك تصورتُ لكل مرحلة من هذه المراحل سؤالًا محوريًّا كان للناس مَدارَ التفكير والأخذ والرد؛ ففي المرحلة الأولى كانت الصدارةُ للمشكلة السياسية الاجتماعية؛ مَن ذا يكون أحقَّ بالحكم؟ وكيف يُجزى الفاعلون بحيث يُصان العدل كما أراده الله؟ وفي المرحلة الثانية كان السؤال الرئيسي: أيكون الأساس في ميادين اللغة والأدب مقاييسَ يَفرِضها المنطق لِتُطبَّق على الأقدمين والمحْدَثين على سواء، أم يكون الأساسُ هو السابقاتِ التي وردَت على ألسنة الأقدمين فنَعُدَّها نموذجًا يُقاس عليه الصواب والخطأ؟ وفي المرحلة الثالثة كان السؤال هو هذا: هل تكون الثقافة عربيةً خالصة، أو نُغذِّيها بروافدَ مِن كل أقطار الأرض لِتُصبِح ثقافة عالمية للإنسان من حيث هو إنسان؟ وجاء القرن العاشر فأخذ يضمُّ حصاد الفكر في نظرات شاملة؛ شأن الإنسان إذا اكتمل له النُّضج واتسَع الأفق، وها هنا كان العقل قد بلَغ مَداه، فجاءت مرحلةٌ خاتِمة يقول أصحابُها للعقل: كفاك! فسبيلنا منذ اليوم هو قلوب المتصوفة.
وأما القسم الثاني من الكتاب ففيه نظرةٌ موجزة إلى الوجه الآخر من قطعة النقد، حتى لا نرى الحقيقةَ من جانب واحد؛ فإلى جانب الوقفات العقلية عند أسلافنا كان هنالك حالاتٌ رفَضوا فيها أحكام العقل ولاذوا بما نبضَت به قلوبهم حينًا، وبما أشبَع فيهم خيال الأيفاع حينًا آخر، وحاوَلتُ جهدي أن أُحلِّل المعنى المقصود بمصطلَح «اللامعقول» حتى لا يَنصرف في الأذهان إلى شتم وازدراء، إنما هو لونٌ آخر يَنبع عند الناس دائمًا من صميم فِطرتهم الإنسانية، وكل ما في الأمر أنني لا أجد هذا الجانبَ من السابقين قنطرةً تصلح لعبور اللاحِقين إذا أرادوا وَصْل الطريق، واكتفيتُ من جانب اللامعقول هذا بصورتَين: التصوُّف إحداهما، والسحر والتنجيم ثانيتُهما، ورأيتُ في ذلك ما يَكفي لاكتمال الصورة التي أردتُ رسْمَها أمام القارئين.
إنني في هذا الكتاب شبيهٌ بمُسافر في أرض غريبة، حط رحالَه في هذا البلد حينًا، وفي ذلك البلد حينًا، كلما وجد في طريقه ما يَستلفِت النظر ويَستحق الرؤية والسمع، ومثلي في رحلتي هذه مثل السائح؛ قد يُفلِت من نظره أهمُّ المعالم؛ لأنه غريبٌ لا يعرف بادئَ ذي بَدْء أين تكون المعالم البارزة، إلا إذا اهتدى بدليل من أبناء البلد، ولكنني أيضًا — مثل السائح الغريب — قد تقع عيني على شيء لا تراه أعيُن أبناء البلد؛ لأنه مألوف لهم حتى لم يَعودوا قادِرين على رؤيته رؤية صحيحة، ومن هنا كنتُ لا أستبعد وقوعي في أخطاء بمَعنيَين؛ بمعنى إهمال ما لم يَكُن يجوز إهماله من معالم الطريق، وبمعنى وقوف النظر أحيانًا عند ما لا يستحق الوقوف عنده بالنظر، وواضحٌ أنه لو أراد مُسافر آخرُ أن يَستبدل لرؤيته منظارًا بمنظار لرأى رؤيةً أخرى، وانتهى إلى أحكام أخرى غيرَ التي رأيتُ وإليها انتهيت.
وإني إذا رجوتُ لهذا الكتاب رجاء، فذلك أن يَجيء خيره أكثرَ من شره، وصوابُه أكبر من خطئه.