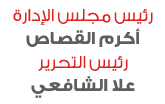ما زلنا مع الحديث عن الأكاذيب التاريخية الأكثر شيوعًا، فأرجو من القارئ العزيز مراجعة الحلقات السابقة من هذه السلسلة من المقالات.
15 حقيقة الجزية التى يخفيها المتطرفون
«الجزية هى مبلغ يدفعه الذين رفضوا اعتناق الإسلام، جزاء لهم لبقائهم على دينهم».
هذا القول الكارثى صادفته فى بعض الكتب «الدينية»، وأقول «الكارثى» لأنه يغير الحقيقة التاريخية لمفهوم الجزية بشكل يحولها لـ«عقوبة» تقع على إنسان لمجرد ممارسته حقه فى اختيار دينه، مما يجعلها كذلك وسيلة إكراه فى الدين!
ذلك المعنى المغلوط للجزية يحرص المتطرفون على إشاعته، كجزء من مجهودهم المستمر لصياغة نسخة متطرفة من الإسلام تقوم على احتقار وامتهان وكراهية الآخر، وتأكيدًا منهم لإقصاء غير المسلمين من أى مشروع لدولة يتخيلونها فى عقولهم المريضة، ويروجون لها بين الجهلة والمتهافتين.
فما هى حقيقة الجزية؟
الجزية عرفها البشر عبر التاريخ باعتبارها «مقابلا للحماية»، تدفعها دولة لدولة أقوى لتقوم على حمايتها، أو تدفعها فئة من المجتمع للفئة الحاكمة لتضفى عليها حمايتها.
من أقدم تطبيقات سياسة الجزية ما كان يتلقاه الملوك المحاربون فى الحضارة المصرية القديمة من الشعوب والدول الخاضعة لحمايتهم فى منطقة الشرق الأوسط حاليًا، فالملك المحارب تحتمس الثالث، بعد انتصاره الكبير فى موقعة مجدو، تلقى الجزية من شعوب مدن الشام، ومن مملكتى بابل وآشور، وحتى من جزيرة قبرص، مقابل قيام المملكة المصرية بحماية تلك البلاد عند اللزوم.
والمدن اليونانية القوية، مثل أثينا، تلقت جزية آسيا الصغرى لحمايتها من أى عدوان.
والدولة الأشورية العراقية فرضتها على الدول الأضعف، التى أجبرتها آلة الحرب الأشورية على الانضواء تحت جناحها، حتى إن حزقيا ملك المملكة اليهودية «يهودا» قد اضطر لتقشير الذهب عن باب هيكل سليمان فى أورشليم، ليتمكن من دفع الجزية.
فرض الرومان كذلك الجزية على مملكتى الأنباط فى الأردن وتَدمُر فى سوريا، باعتبارهما تحت حماية النسر الرومانى.
لم يكن فرض المسلمين الجزية على غير المسلمين إذنا بالشىء الذى ابتدعه المسلمون، ولم يكن بمثابة العقوبة ولا وسيلة الضغط،
فمن ناحية، يتناقض مفهوما العقوبة والضغط مع مبدأ أن «لا إكراه فى الدين»، ومن ناحية أخرى، فالجزية لم تُفرَض على جميع غير المسلمين، بل على فئة بعينها منهم «القادرون على القتال»، فلو كانت عقوبة، ما كانت لتفرض على إنسان دون غيره.
إليك ما يؤكد أن الجزية هى مجرد مقابل للحماية:
الجزية فُرِضَت على كل ذكر بالغ عاقل صحيح الجسم والعقل، مقتدر ماديًا، وأعفى منها كل من «الأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين والمعاقون والمجانين وأصحاب الأمراض الخطيرة المزمنة والفقراء» أى من لا يستطيعون القتال ولا التجهز للقتال ونفقاته.
والجزية كانت تجب فقط، حال تولى المسلمين الدفاع عن غير المسلمين، وتسقط إن لم ينفذ المسلمون هذا الشرط، كما جرى فى مدينة حمص السورية، عندما فتحها المسلمون ثم اضطروا للانسحاب عنها أمام الروم تكتيكيًا، فرد أبوعبيدة بن الجراح، قائد جيش المسلمين، مبلغ الجزية لأهل حمص، لأنه لن يقدر على رد الروم عنهم.
كانت الجزية تسقط كذلك باشتراك غير المسلمين فى الدفاع عن البلد، كما جرى فى بعض مدن الشام، حيث عرض أهل تلك المدينة ألا يدفعوا الجزية مقابل قتالهم مع المسلمين، فوافق الخليفة- آنذاك-عمر بن الخطاب، بل وكان يتم توظيفها للإنفاق على تسليح غير المسلمين، مثلما كان مع أهل أرمينيا عند فتحها، فقد اتفقوا مع المسلمين أن يشكل الأرمن جيشهم الخاص، وأن تخصص الجزية للإنفاق عليه.
وقد انتهى العمل بالجزية فى مصر فى عهد الوالى سعيد باشا بن محمد على باشا، حيث أصبح النظام أن يتم تجنيد المصريين باختلاف أديانهم، وهو ما يتماشى مع نظام جولة المواطَنة، حيث إن كل المواطنين متساوون أمام القانون، ومتفقون فى الواجبات الوطنية، وهو ما لا يناسب، بالتأكيد، نظرة المتطرفين للدين والمجتمع.
16 المصريون القدماء كانوا يعبدون ملوكهم
هذه واحدة من سلبيات خلط الدين والتاريخ، فالتاريخ علم مستقل بذاته، وإقحام الدين فيه يفسد كلا منهما، فكم من أناس يسقطون قصة فرعون موسى على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، فيطلقون حكمًا جاهزًا أن الملك/ الفرعون كان إلهًا أعلى للمصريين!
شغل أكثر من إله مصرى قديم منصب «كبير الآلهة»، الأول كان «بتاح»، الذى كان معبده فى العاصمة القديمة، منف، سببًا لتسمية العاصمة، بل ومصر كلها «حتكا بتاح»، أى جدار معبد بتاح، وهو الاسم الذى نطقه اليونانيون «كبتوس» لتشتق منه لغظة «قبط»، وليتحول فى اللغات الأوروپية إلى Egypt و Égypte و Ägypten.
ثم أصبح رع/ الشمس كبيرًا للآلهة، ولمجمعهم الذى ضم آلهة شهيرة مثل إيزيس وأوزيريس وحورس وست وغيرهم، ومن بعد رع جاء آمون الذى تحول بعد ذلك إلى آمون رع، وتحت راية آمون حارب سقنن رع ثم ابناه، كاموس وأحمس الهكسوس، وحرروا مصر منهم.
وفى العصر البطلمى، دمج البطالمة الإلهين أوزيريس وأبيس فى إله واحد ذى هيئة إغريقية هو سيرابيس، ومعه زوجته إيزيس وابنهما حربوقراط.
فما موقع الملك إذن من الألوهية؟
الملك كان يمثل للمصريين تجسيدًا للإله حورس، أى أنه لم يكن هو نفسه حورس، بل ممثلًا دنيويًا عنه، وعند وفاة الملك كان يلحق بأوزيريس، فيقال عن الملك «أوزيريس فلان»، أى أقرب لأن نقول «المرحوم فلان»، مع اختلاف المنطلق العقائدى.
لم تتم عبادة أى من الملوك المصريين القدماء إلا بعد موته، كنوع من التكريم لبعض هؤلاء الملوك، ولكن ليس باعتبارهم آلهة أصلية بل بنظرة أقرب لنظرة المسيحيين والمسلمين للأولياء الشفعاء أو القديسين الحماة، ومن أمثلة ذلك قيام الملك المحارب تحتمس الثالث ببناء معبد لسلفه العظيم سنوسرت الثالث عند الشلال الثانى من النيل، اعترافًا من تحتمس الثالث بعظمة هذا الملك الذى سبقه بقرون، وقيام الملك أحمس ببناء معبد لجدته الملكة العظيمة توتيشيرى تكريمًا لها لدورها فى الكفاح ضد الهكسوس.
كان الملك كذلك بمثابة ابن للإله، فكانت تكتب له قصة «ميلاد ملكى» كالتى دونتها الملكة حتشبسوت على جدار معبد الدير البحرى بالأقصر، أو كتنصيب كهنة معبد آمون فى سيوة للإسكندر المقدونى ابنًا للإله، أو كادعاء كليوپاترا أن ابنها من يوليوس قيصر هو ابن آمون، وغيرها.
وبينما كان الإله الأكبر معصومًا بطبيعته، وموقعه محصن بذاته، كانت قدسية منصب الملك المصرى القديم تأتى من عدله وحكمته وقيامه بمهامه على أكمل وجه، فلم تكن قدسية منصبه الملكى بمثابة تشريف، بل كان بقاؤها مرهونًا بالتكليف.
وللحديث بقية إن شاء الله فى الحلقة المقبلة من هذه السلسلة من المقالات.. يتبع.